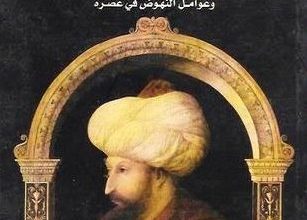في ذكرى إلغاء الخلافة الإسلامية: السياسة تتلاعب بالتاريخ (2)
نظرات في خلط المفاهيم المتعلقة بالقضية الفلسطينية بين الزمن العثماني وزمن الاستعمار الغربي والتجزئة العربية
محمد شعبان صوان
في مقال سابق، هو “في ذكرى وعد بلفور: السياسة تتلاعب بالتاريخ“، تحدثت عن الأثر الحاسم لتغير السيادة على فلسطين في قيام المشروع الصهيوني، وعن تلاعب السياسة المعاصرة بهذه الحقيقة لتبرئة نفسها من ذنب فلسطين وإلقاء “المسئولية الكاملة” على السابقين، وفي هذا المقال أتابع بالحديث عن إهمال “تبدل السيادة” في الأبحاث ذات الصبغة الدعائية السياسية مما أدى إلى خلط المفاهيم والمصطلحات وأربك عملية القراءة عن تلك المرحلة.
۞أثر الصراعات السياسية في تشويه الحقائق التاريخية
في غمرة الصراعات الدموية التي تشهدها بلادنا في هذا الزمن، يستخدم الخصوم كل الأسلحة الممكنة للانتصار والظهور على بعضهم البعض، وفي هذه المعمعة، تستخدم الدعاية الإعلامية التاريخ في سبيل دعم مواقف أطرافها المتنازعة، فليس هناك أرسخ من الماضي لإثبات شرعية الحاضر، فهذا الزعيم هو سادس الراشدين وآخر هو هارون الرشيد، وذاك هو صلاح الدين الأيوبي، ورابع هو محمد الفاتح، ويتلقى الخصم هذه الإعلانات مصادقاً عليها وهو متعجل للنزال والدحض بدلاً، مثلاً، من تفنيدها بالفصل بين الماضي والحاضر، كما يرفض المسلم بشكل قاطع أن يبلع طعم أعدائه، فيأبى الربط بين الصهيوني وسيدنا موسى عليه السلام، أو بين الفرنجي القديم أو المحافظ الجديد وسيدنا عيسى عليه وعلى كل الأنبياء السلام، ولكن هذا لا يحدث في صراعات بلادنا الحالية، يقول طرف أنا صلاح الدين، فيبلع خصمه الطعم ويتعجل ويطعن صلاح الدين ظاناً أنه يطعن خصمه، وتضيع الحقيقة وتتيه الأجيال ويداس وعيها وتدمر رموزها وما تمثله من قيم في سبيل الصراعات على الأمجاد السياسية الزائفة.
۞الأهداف السياسية تطيح بالمصداقية
وتصرح الدعاية السياسية الحالية ضد تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني، كما يقول مثلاً مؤلفو كتب “دور السلطان عبد الحميد” و “الذات المقدسة”، بأن غرضها سياسي معاصر هو الدفاع عن النماذج العربية الثورية أو دحض حجة الدول أو الحكومات أو الأطراف التي تتخذ السلطان مثلاً أعلى، وبعض هذه الكتب مثل “التاريخ المجهول: المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين” قدم دفاعاً فروسياً عن فلسطين ضد استبداد وتسلط العثمانيين، ولكن ما لبث مؤلفه أن أصبح مسئولاً كبيراً في حكومة ضربت الرقم القياسي في الديكتاتورية من جهة، والتآمر على فلسطين ومقاومتها، والاستسلام للصهاينة وخدمة مصالحهم، وهو يصور كل ذلك بفجر الإنقاذ ووضع الأسس الجديدة لحياة أفضل، وتلك الأهداف السياسية من جهة، والازدواجية في المثال والواقع، كل ذلك في حد ذاته يطيح بمصداقية الدعاية السياسية لأنها قائمة على توظيف نفعي للماضي يضع النتيجة مسبقاً في خصومات مريرة فيلوي أعناق الحقائق الماضية في سبيل غرض جاء في وقت لاحق، فمن يزعم مثلاً أنه يريد دحض حجة أبي بكر البغدادي وهزيمة دولته، يمكنه ذلك ولكن دون المصادقة على زعمه بأنه امتداد لقرون مزهرة صنعتها الخلافة الإسلامية وشهد لها العدو قبل الصديق، فمن ينبري لمحاربة البغدادي ولكنه يقبل ادعاءه بالتطابق مع الماضي رغم وجود الفارق العظيم المدرك بأقل وسائل الإحساس بين الماضي والحاضر، فإنه يثبت إما جهلاً فاضحاً أو غرضاً خبيثاً بتشويه حضارة هي من مفاخر التاريخ البشري، كما أن صاحب الفكرة الذي لا يلتزم بفكرته ويقتصر على ذم الآخرين حين يظن أنهم غير ملتزمين بها، يفقد المصداقية ولا يؤخذ كلامه على محمل الجد.
۞من وسائل التزييف: انتزاع المفاهيم من زمنها وإسقاطها على زمن آخر
وهكذا تصنع الدعاية السياسية ضد تاريخ السلطان عبد الحميد، ففي سبيل إثبات حججها المتغيرة حسب توجهات الأنظمة الحاكمة، تقوم بإسقاط هموم الحاضر على حوادث الماضي، وتنقل هذه الحوادث من زمنها إلى الزمن المعاصر فتكون النتيجة تشويهاً هائلاً للتاريخ: فما حدث في الماضي من تقديم طلبات لسكنى اللاجئين اليهود في الدولة العثمانية، مع القبول بسيادتها وقوانينها، ودون اقتطاع أي جزء من أراضيها، وما تبعه من أحاديث تستطلع المطلوب وتقترح، مجرد اقتراحات نظرية، من شخصيات مختلفة المستويات والتوجهات، مسارات معينة لقبول هؤلاء اللاجئين هنا أو هناك تحت سيادة الدولة وقوانينها، وحتى هذا فشل كله في تحقيق أي نتيجة للطالبين، ينقلب كل ذلك بفعل الآلة الإعلامية إلى مفاوضات على بيع أراضي الدولة في المزاد والتخلي عن سيادتها لتثبيت كيان صهيوني مستقل، وهو ما يحدث في سياسات اليوم تماماً ولهذا يتبادر إلى ذهن القارئ البسيط وهو يرى ألفاظ: مفاوضات، يهود، صهاينة، عروض، بيع، استقلال، مستوطنات.
ولكنه ليس ما حدث في الماضي، فهرتزل ليس بن غوريون، ولم يكن يملك قدرات الاستقلال، وأقصى ما طالب به هو الاستقلال الذاتي على غرار أقاليم أخرى في الدولة، والمفاوضات كانت على بيع عقاري كأي عملية شراء أرض أو بيت في أي مكان في العالم، وليست تنازلاً عن السيادة، وقد جرت أصلاً لأهداف بعيدة كل البعد عن فلسطين ولهذا انتهت بفشل مسعى هرتزل لمّا تحقق الغرض العثماني، ولكن الإصرار على الانتقادات الدونكيخوتية يحفر في الصخر لاستخراج عيب مهما كان واهياً: طول فترة المفاوضات منح اليهود مكسباً من التسلل، مع أن هذا المكسب نفسه كان فاشلاً في تقدير أصحابه أنفسهم.
ولو كانت السيادة تنتقل ببيع العقارات لصارت السيادة على مناطق كثيرة وواسعة من بريطانيا وتركيا ولبنان لعرب الخليج اليوم، والعروض المقدمة آنذاك عروض لجوء ككثير من عروض اللجوء التي قبلت بها الدولة العثمانية منذ سقوط غرناطة، وليست عروض استقلال، والبيع لا ينقل سيادة أصلاً، ومع ذلك لم يحدث، والمستوطنات اليهودية في فلسطين العثمانية ليست الكيان الصهيوني المتغوّل، ولم تكن كلها أصلاً تتبع الصهيونية، بل كان كثير منها تابعاً لخصوم الصهيونية من الباحثين عن المعيشة وحدها، وشراذم يهود القرن ١٩ الفارين من مجازر روسيا القيصرية بأحوال مزرية ولا يجدون من يستقبلهم ولا من يقدم الدعم لهم، ليسوا عصابات صهاينة النكبة التي اتفق على دعمها الشرق والغرب، والاستقلال الذي جرى الحديث عنه في ذلك الزمن هو الاستقلال الذاتي الذي كان السلطان عبد الحميد يمقته ويحذر منه ولكن غيره يرى الفائدة في حضور اليهود، ولم يفاوض أحد من العثمانيين على الانفصال التام كالذي جرى على فلسطين بعد ذلك بالقوة، ولهذا فإن إدانة الحوادث في زمن العثمانيين تعتمد على خلط المفاهيم، فما حصل عليه اليهود، أياً كان، كان في إطار السيادة العثمانية، وما منع عنهم، كان خشية من استقلالهم الذاتي، وليس من الانفصال الذي كان خارج كل الاحتمالات ولم يكن محل نقاش، كل ما حصل من التشدد أو التساهل أو التضييق أو الثغرات كان في إطار السيادة العثمانية، كما تتشدد اليوم أو تتساهل أي دولة تجاه الجاليات والأقليات المقيمة فيها، لا يقال مثلاً إن سماح دولة عربية باستيراد مفتوح للعمالة الآسيوية لخدمة مواطنيها، يعني تساهلاً يؤدي إلى الخيانة العظمى بتسليم سيادة البلد للأغراب، لأن هناك دولة وهناك سيادة يتم في ظلها دخول الوافدين ويمكن أن يخرجوا بجرة قلم كما دخلوا، وتسهيل السيطرة السياسية الآسيوية يتطلب انقلاباً جذرياً في الأوضاع السياسية تصنعه حروب كبرى تغيّر ترتيب المنطقة من جذوره وتستغل مكوناتها السكانية في الرفع والخفض خلافاً لما كان موجوداً وذلك لتحقيق مصالح أطراف جديدة، وإن اطمئنان الدول الخليجية ومواطنيها اليوم رغم ضخامة الحضور الآسيوي الوافد، مستند إلى سيادتها القائمة، رغم التحذيرات من بعض المستشرفين لآفاق المستقبل، ولكن الحياة مستمرة في ظل واقع لا يتوقع أحد انقلابه من جذوره، وهذا ما حصل في بلادنا التي كانت مستندة إلى سيادة عثمانية عمرها قرون، وهي ليست مجرد دولة صغيرة، ولكن كل شيء انقلب رأساً على عقب بعد الحرب الكبرى الأولى، فلا نستطيع اليوم أن نلوم جزئية في السياسة العثمانية كما لا يمكننا أن نلوم استمرار تدفق العمالة الآسيوية في بلدان خليجية صغيرة، فالسيادة وزوالها هي الفرق الحاسم، والزمن العثماني غير الزمن البريطاني وما تلاه، والظروف متباينة جداً.
۞حقيقة إطار الخلاف في الدائرة العثمانية على قبول الاستيطان اليهودي
هرتزل كان مجرد صحفي أفّاق ومغامر، وفلسطين في زمنه أرض عثمانية يسكنها غالبية عربية ساحقة ظلت كذلك إلى نهاية العهد العثماني مع أقلية يهودية غير مرئية، وهرتزل يطلب لليهود قطعة أرض يشتريها كما يشتري الغريب عقاراً في أي بلد للسكنى فيها ويحصل على الجنسية، وليس لإقامة دولة منفصلة، فلا تصبح له السيادة على عقاره ويظل تابعاً للدولة التي فيها العقار الذي صار يملكه، فانتقال ملكية الأرض لا غبار عليه في هذا الظرف، مثل أي عملية شراء عقاري في كل العالم، ويكون الخلاف بين مسئولي الدولة على نفع هؤلاء اللاجئين للدولة، وليس على استقلالهم عنها، الاستقلال هو ما يرفضه الجميع، ولم يكن قبولهم في الدولة قط قائماً على تمكين هؤلاء اللاجئين من تملك البلد والاستقلال به وطرد أهله، وفي هذا الإطار الاستيعابي صدرت كل الاقتراحات، ومع ذلك يرفض السلطان كافة العروض التي تمس هواجس الاستقلال الذاتي عنده، ولو كان هناك أي مسئول في إدارة السلطان، أو في أي دولة في العالم غير بلادنا، يفكر مجرد تفكير ببيع قطعة أرض من الدولة فضلاً عن أرض مقدسة لكان مصيره الطرد والعقاب الشديد بتهمة الخيانة العظمى بلا شك، حتى علي نوري بك الدبلوماسي العثماني في فيينا عندما عرض على هرتزل اقتراحاً مسرحياً من عنده بضرورة خلع السلطان عبد الحميد بعد قصف قصره بالبوارج لنجاح مشروع الاستيطان اليهودي[1]، لم يكن يعني التنازل عن سيادة الدولة بل العمل على نجاح مشروع رآه البعض مفيداً للدولة وليس منتقصاً إياها، المعارضة كانت تتحدث عن خلع السلطان ولكن لا أحد يجرؤ على التحدث عن بيع أراضي الدولة، ولهذا كان تنصيب سلطان جديد في رأي أنصار الاستيطان في الدولة العثمانية سيفيدها.
هذا كان رأي مخالفي السلطان عبد الحميد ومنهم الاتحاديون، تحدثوا عن خلع السلطان ولكنهم لم يتحدثوا عن خلع سيادة الدولة على أي من أراضيها، بل كان مأخذهم على السلطان هو خسارته لبلاد احتلها الأوروبيون بقوة السلاح، ولما وصلوا هم إلى الحكم خسروا مساحات أوسع ولكن لم تتنازل الدولة في عهدهم عن سيادتها على أي أرض بلا دماء غزيرة وظروف قاهرة تتراجع أمامها أي دولة مهزومة في العالم، نعم ظن الاتحاديون أن الاستيطان اليهودي سيفيد الدولة لا أنه سينزع سيادتها، هذا كان رأيهم لفترة قبل تراجعهم عن هذا الرأي، لا أنهم رغبوا في زوال الدولة أو التنازل عن سيادتها على أي قطعة منها أو بيعها في المزاد السلمي لأي جهة فضلاً عن جهة حقيرة كالمنظمة الصهيونية، لقد ظنوا كما ظن الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي ومن وافق على المشروع في بداية عهد السلطان عبد الحميد أن دخول لاجئين أثرياء ومتعلمين سينعش الدولة، لا أن يسلبها، وذلك كما تستفيد أي دولة اليوم من الجاليات الأجنبية المقيمة فوائد مالية أو وظيفية أو دفاعية أو حتى سكانية، وهذا ما صرّح به صبحي بك متصرف القدس الذي خلف علي أكرم بك الذي كان السلطان عبد الحميد قد عيّنه ليتشدد في منع الهجرة والاستيطان قبل عزله بسنتين، ولما جاء عهد الاتحاديين عينوا صبحي بك، كان رأيه حرفياً أن اليهود “مخلصين” للدولة وسيفيدها وجودهم من النواحي المالية والتجارية والزراعية والعلمية[2]، كما استقبلت الدولة ملايين اللاجئين على مدى تاريخها وسكنوا إلى جانب أهلها، فلم يكن أحد يتحدث في استقبال اللاجئين عن بيع سيادة أو طرد أهالي أوعن التنازل عن فلسطين لسيادة أخرى.
فيجب أن نفهم الظرف الذي جرى فيه أي تأجير أو بيع أو استيطان أو هجرة، لأن لفظ البيع قد يتضمن خيانة بالتنازل عن السيادة، وقد يكون أيضاً مجرد صفقة تجارية داخلية تتم في كل يوم في جميع أنحاء العالم، والهجرة قد تكون هجرة استيطانية إحلالية كما يحدث اليوم في فلسطين، وكما حدث في الأمريكتين وأستراليا سابقاً بعدما تفاقمت أعداد الهجرات التي كانت في البداية سلمية ولاجئة، وقد تكون الهجرة لجوءاً كما حدث في فلسطين القرن التاسع عشر وفي بلاد العرب بعد الربيع العربي، وما يحدث في بورما وما حدث في البوسنة سابقاً، والاستيطان قد يكون إجرامياً إحلالياً وقد يكون مجرد هجرة شرعية بموافقة الدولة صاحبة السيادة التي تطلب بنفسها المهاجرين بسبب توفر كفاءاتهم للاستيطان فيها كما تعرض بلاد المهجر مثل أمريكا وكندا وغيرهما، ومع ذلك تحرص على تطبيق قوانينها عليهم، وكما أكدت على ذلك الدولة العثمانية، ولكل هذا ففهم زمن ومكان المصطلح وظروفه يوضح ما المقصود منه، والباحث الذي لا يوضح ذلك لقارئه يجانب الأمانة العلمية والرصانة التي يفترض تحليه بها.
أما كون هجرة معينة انقلب حالها من اللجوء المعيشي إلى الاستيطان الإحلالي بعد زوال سيادة الدولة التي استقبلت اللاجئين وحلول سيادة جديدة حوّلتهم إلى مستوطنين إحلاليين فهذا ليس جريمة الدولة السابقة بل جريمة الدولة اللاحقة، وكثيراً ما شاهدنا في زمننا المعاصر جلاء جاليات كبرى كانت تعيش حياة اللجوء في دول رأت هذه الدول فيما بعد أن وجود هذه الأعداد الضخمة ضاراً بمصالحها، لأسباب اقتصادية أو لوجود خلافات سياسية، ولهذا تخلصت من هذه الجاليات بموجب سيادتها القائمة، فخرج مئات الآلاف أو حتى ملايين في مدد قصيرة، وهذا يعني أن وجود أي جالية في ظل سيادة لا يعني خطراً إلا بعد زوال السيادة وحينئذ لا ملامة على السيادة السابقة التي وافقت على دخول تلك الجالية.
۞واقع الأقلية اليهودية ومطالب هرتزل في ظل السيادة العثمانية
الزعيم المصري الكبير مصطفى كامل باشا قابل هرتزل أكثر من مرة وأثنى على ولاء اليهود وسكونهم وحيادهم في الدولة خلافاً لغيرهم من الأقليات المتمردة والمتعلقة بالأجانب[3]، ذلك لم يكن خيانة ولا تنازلاً، فليس الباشا من الخونة ولا من المفرطين، هو رمز مقاومة شرسة للاحتلال الأجنبي وإخلاص متفان في ولائه للخلافة، وطهارة فريدة في تعلقه بالمثل العليا، بل وبصيرة كشفت له ما لم يعرفه غيره إلا بعد زمن طويل، وما غاب عن كثيرين في زمنه، على صغر سنه في ذلك الوقت، ولكنه ينظر إلى واقعه الذي كان في زمنه، فاليهود كما رآهم أقلية ساكنة وليست مرتبطة بالدول الكبرى التي كان الباشا يحاربها ويناضل ضد نفوذها الضار بحرية بلاده وبسيادة الخلافة الإسلامية، وليس مطلوباً إليه التنبؤ بما سيحدث بعد عشرات السنين بعدما تتغير صورة العالم من جذورها بشكل غير متوقع، كلامه وصف لوضع أقلية لم تخرج عن حدودها تحت سيادة الدولة الإسلامية ولم تكن في وارد إعلان دولة مستقلة وهي ترى ما جرى في الأحداث الأرمنية بسبب رغبة القوميين الأرمن في الانفصال، هذا إطار الحدث التاريخي، ولكن مع ذلك فإن السلطان يرفض كل العروض، ورفضه كان بسبب رغبته في الحفاظ على الطابع العربي لفلسطين، وعدم إيجاد مشكلة أقلية جديدة ذات استقلال ذاتي، أما التنازل عن السيادة العثمانية هكذا بكل بساطة فلم يتحدث عنه مؤيد للهجرة ولا معارض، كان ذلك خارج كل النقاشات والاحتمالات إلا لو سقطت الدولة نفسها، بل كان عرض هرتزل وكلام المؤيدين لهجرة اليهود واستيطانهم أن وجود اليهود سيقوي وينهض الدولة، وأكد هرتزل للسلطان أن الدول الكبرى لا ترغب في هذا الإحياء، أي أن وجودهم سيكون داخلها للدعم والإسناد[4]، وليس للانفصال والإضعاف، هذا كان محور الكلام مع السلطان، ويجب على من يريد شهادة هرتزل كاملة أن يطالع ذلك، ولكن السلطان يرفض كل الإغراءات لأنه يدرك نوايا الاستقلال الذاتي الذي يمقته (عندما كان هرتزل قبل وفاته بقليل في مقابلة مع ملك إيطاليا في يناير 1904، جرى الحديث عن فلسطين، قال هرتزل: نريد استقلالاً ذاتياً، فرد الملك: إنه (السلطان) لا يريد سماع هذه الكلمة، إنه يمقتها[5])، فيغادر هرتزل إسطنبول ويصرح بأن أحلامه تحطمت في وكر لصوص علي بابا، كما قال، وتغيير هذه الأوضاع كلها احتاج حرباً عالمية كبرى اندلعت بشرارة غير متوقعة وقلبت الواقع من جذوره، وجاءت بترتيبات جديدة كلياً هي التي منحت الصهاينة أوضاعاً مضخمة، لم يدرك أبعادها كثيرون إلى وقت متأخر.
وبالمناسبة فقد استمر هذا الرأي الإيجابي في الهجرة اليهودية في فلسطين نفسها إلى زمن متأخر من عهد الانتداب البريطاني قبل أن تتضح الرؤية للجميع بجلاء وهم يرون كارثة المجازر والطرد الجماعي الزاحفة عليهم، وحتى وقتئذ لم يكن حجم الكارثة واضحاً لأن الكثيرين ظنوا أنها معركة عابرة سرعان ما تنجلي ويعود الناس إلى بيوتهم لتناول الطعام الذي تركوه ينضج على نار هادئة قبل خروجهم، كما خرجوا وعادوا في أكثر من مناسبة قبل ذلك، في الحرب الكبرى الأولى في العقد الثاني من القرن العشرين ثم في الثورة الكبرى في الثلاثينيات.
۞الفروق الجذرية بين البيع الذي طلبه هرتزل من العثمانيين، والتنازل العربي الذي حصل عليه خلفاؤه
القصد أنه في قراءة التاريخ يجب قراءة الحدث في زمنه وظروفه وليس وفق معايير وظروف أزمان لاحقة، ولا إسقاط هموم الحاضر على الحدث القديم، وما يحدث اليوم من إطلاق دعايات سياسية يقوم على اقتطاع حدث التفاوض القديم من زمنه وإسقاطه على زمننا لإيجاد انطباع سلبي يستهدف الطعن في أطراف حية ومعاصرة بحجة استرشادها بشخصيات الماضي، وهذا يشبه محاولة دحض الفكر الصهيوني بالطعن في الأنبياء الذين يزعم هذا الفكر أنهم مثله العليا، أو محاولة دحض الفكر المتطرف بالطعن في الإسلام نفسه رغم أن معظم مخرجات الإسلام التاريخية كانت مختلفة، ولكن توتر الحوارات في بلادنا تجعل أي طرف تواقاً لأي حجة تدعم موقفه حتى لو كانت واهية، وهذا هو حال اقتطاع المشهد التفاوضي بين الدولة العثمانية والصهيونية من زمنه حيث طلب الصهاينة شراء أراض لإقامة لاجئين بزعمهم مع إقرارهم بالسيادة والقوانين العثمانية، فالاستقلال التام لم يكن وقت الحديث فيه آنذاك وهم يدركون ذلك جيداً ويؤكدون على رغبتهم في الخضوع للسيادة القائمة والسكن في ظلها، كما يفعل اليوم أي مشتر غريب لعقار في بلد أجنبي، دون حصوله على سيادة فوق عقاره، رغم صك الملكية، هذا كله يقتطع من سياقه التاريخي ويسقط على ظروف زمننا حيث المفاوضات على التسليم بالتخلي عن فلسطين لسيادة كيان أجنبي معاد قتل وطرد أبناء البلاد وأحل غيرهم محلهم، وصار خنجراً في قلب أمتنا، فيتصور القارئ أن مفاوضات الماضي هي نفسها تنازلات الحاضر، وهذا انطباع مزيف ومحرف، من الاشتراك اللفظي في كلمة (المفاوضات)، ولهذا قال أحد متهمي السلطان إنه يكفي أنه “كان في حالة تفاوض” لإثبات تنازله وتفريطه، ولكن تمهل يا أستاذنا، فالتفاوض مع التسليم المسبق بالسيادة العثمانية على فلسطين يتناقض مع التفاوض مع التسليم المسبق بالسيادة الصهيونية على معظم فلسطين وفقاً “للشرعية الدولية” التي يقر بها الزعماء العظماء في زمننا، والتفاوض لاستقبال لاجئين يتناقض مع التفاوض مع الإقرار المسبق “بحق العودة اليهودي”، والتفاوض مع التلاعب بهرتزل لاستخدامه أداة في السياسة المالية للدولة البعيدة حتى عن نوايا البيع العقاري، يتناقض مع اللهاث خلف التفاوض مع مجرمي الحرب الصهاينة لإقناعهم بقبول استسلامنا لهم، والتفاوض الذي ينتهي بعلبة سجائر فاخرة يختلف عن التفاوض الذي ينتهي بتسليم فلسطين لسيادة الأعداء، والتفاوض ثم رفض التوقيع على مشروع صهيوني قدّم كل التنازلات للجانب العثماني، يتناقض مع تفاوض يلهث لتقديم التنازلات للجانب الصهيوني، وحين لا يوقع الزعيم الملهم فلأن الصهيوني المتغطرس هو الذي أفشل حفلة التوقيع، فالمشهدان متباعدان جداً، ولكن التزييف هو غرض الدعاية السياسية لتسجيل النقاط في الصراعات بين الأحياء التي تذهب بوعي الأجيال.
۞واقع طلبات لجوء اليهود للدولة العثمانية
ولو فكر أي مسئول عثماني في استقبال لاجئين في أي مكان في الدولة فهذا تماماً مثل استقبال اللاجئين في عاصمتها إسطنبول، كما تستقبل أي دولة أي لاجئين، وهو ما يحدث للاجئين السوريين اليوم وما حدث للاجئي فلسطين في الماضي، ولا يفسر أحد ذلك بالبيع والتنازل، هذا كان موضع الخلاف في الدولة منذ عرض لورانس أوليفانت مشروعه الصهيوني على مسئولي السلطنة في بداية عهد السلطان عبد الحميد، قبل هرتزل بسنوات طويلة، فرضي به الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي وغيره من المسئولين ولكن عندما وصل إلى السلطان نفسه رفضه رفضاً قاطعاً، ولا يقال هنا إن الصدر الأعظم كان بصدد بيع السلطنة هو أو غيره، ما طرحوه كان مجرد استقبال لاجئين رأى البعض أن إمكاناتهم مفيدة للدولة وسيكونون تحت سلطتها وقوانينها، وهذا ما يجب أن نفهمه في ضوء ما حدث في طول التاريخ الإسلامي وعرضه من استقبال اللاجئين وتطبيق الامتيازات الأجنبية التي قدمتها الدولة في زمن قوتها واستقبلت بموجبها جموعاً من التجار الأوروبيين وسهّلت تجارتهم وإقامتهم، وكان منهم تجار يهود أفادوا الحركة التجارية في ذلك الوقت، ثم تحوّل الأمر تدريجياً إلى الآثار السلبية مع تزايد ضعف الدولة بمرور الزمن ومضيّ الوقت وطول العمر، هذا كان الإطار التاريخي لتعامل المسلمين والعثمانيين خاصة مع اليهود، وضمن ذلك يوضع تعبير السلطان عبد الحميد عن حمايته الدائمة وصداقته لليهود لو بحثوا عن (ملجأ) (refuge) في أراضيه[6]، هؤلاء اللاجئون هم الاستمرار للاجئين طوال التاريخ العثماني، ومع تداخل المراحل التاريخية وبدايات الشعور بخطر التدخل الدولي بفكرة (الاستقلال الذاتي) وليس (الدولة المستقلة) بدأت عملية تقنين الاستقبال في أماكن محددة بصفتها (ملاذات) وليست (كيانات مستقلة)، يمكن لكبراء اليهود (شراء عقارات لسكن اللاجئين فيها) تحت سيادة وقوانين الدولة العثمانية وليس (لإعلان استقلالهم فيها)، وتستفيد الدولة من قدراتهم المالية والعلمية في (الترقي) كما يحدث في أماكن كثيرة في العالم وليس (بالانفصال) عنها، هذا ما جرى بحثه في (المفاوضات العثمانية) في غياب قوة إجبارية كبرى، وهي مفاوضات تختلف عن (المفاوضات في الزمن العربي) حيث الإكراه الدولي سيد الموقف الذي تتحكم فيه الدول الكبرى داعمة الصهاينة ولم يكن ذلك حاضراً زمن التفاوض العثماني بل كانت الدول الكبرى تتهرب واحدة إثر الأخرى من تبني المشروع، والتوجه الذي رضي باستقبال اليهود، كان ينظر إلى فوائد الاستقبال ومصلحة الدولة منه، أما المعارضون وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد، فكانوا يخشون فتح الباب للتدخل الدولي القميء الذي لم يكن موجوداً آنذاك إلا بتدخلات جزئية من سفراء وقناصل ودبلوماسيين، تدخلات ليست جذرية ولا تقلب المشهد السياسي في فلسطين ومن هنا كان التجاوب مع بعضها محصوراً في دائرة استمرار الوضع القائم هناك، ومن غير الموضوعي النظر بأثر رجعي إلى هذا التاريخ كله من العدسة الصهيونية الضيقة التي نشأت صغيرة في وقت متأخر من القرن التاسع عشر، ثم من النكبة الفلسطينية الضخمة بعد ذلك، فلم يكن التصور القائم في زمن بدايات الهجرة سوى استمرار لمشاهد الأقليات العديدة واللجوء المستمر ومستوطنات التجار الأجانب الكثيرة، ولم يكن البحث في التنازل عن السيادة التي لم يتركها العثمانيون إلا بحروب طاحنة ودماء غزيرة، وهذا هو الإطار التاريخي للحدث ومن التزييف نقله إلى ظروف الصراع مع الاستيطان الصهيوني زمن الانتداب البريطاني ثم الكيان الصهيوني منذ منتصف القرن العشرين، فجعل عبارة قالها السلطان عبد الحميد في ذكر الأمان الذي يعيش فيه اليهود في عموم الدولة العثمانية، وأن ذلك لا يستلزم الموافقة على المشروع الصهيوني، وقصده الفصل بين التسامح والاستسلام، فتقلب الدعاية السياسية قصد كلامه فتضخمه وتجعله “أكبر عامل جذب لليهود إلى فلسطين” دون الالتفات لعوامل الجذب التاريخي الحقيقية التي صنعت الكيان الصهيوني، أو إلى النتائج التافهة التي حققتها الهجرة في ظل هذا “العامل الأكبر”، وتزعم أن الدولة العثمانية “لم تفعل شيئاً” لمقاومة الهجرة، وهذا كله كذب وتزييف، لأن من يتوقف عند عبارة ويقلب مفهومها ويضخم نتائجها بشكل سلبي، وفي نفس الوقت يتغاضى عن كل الإجراءات العملية التي قامت بها الدولة ضد الاستيطان، ويتغاضى عن الإجراءات العملية التي سلم بها العرب فلسطين لبريطانيا والصهيونية، وعن عبارات زعمائهم الواضحة في قصد الاستسلام دون أي تحريف، هذا كله لا يمكن وضعه في دائرة الغفلة أو السذاجة، هذا كذب مقصود لغايات دعائية سياسية غير شريفة.
۞النقاش عندما يجري على أساس غير تاريخي
ولكن ما يحدث للأسف هو قصور في النظر من جانب المهاجم والمدافع على السواء، يقول الناقد: دخل مهاجرون وأقيمت مستوطنات يهودية في زمن الدولة العثمانية، فيرد المدافع بمحاولة خفض الأرقام وتقليل النسب، وينسى الفروق الجذرية بين عصرين، في حين أن النقاش كله يسقط عصراً ماضياً على زمننا فترتبك الأفهام، حيث يغرق الباحث من الطرفين في لحظته الحالية ويسحب ظرفها الصهيوني الطارئ على كل الماضي الطويل الذي لم يعرف أي صهيونية، ويأتي المدافع بعد أن يبلع الطعم ويتشرب الهجوم فيرد من الموقع الدفاعي الضعيف الذي وجد نفسه فيه ويجهد نفسه في النفي والإنكار والتخفيض من مظاهر الحضور اليهودي دون أن يخطر بباله أن لاجئي غرناطة ومن تبعهم في القرون التالية يختلفون جذرياً عن مهاجري الانتداب البريطاني واليهود السوفييت في القرن العشرين ويهود أوكرانيا اليوم، وأن استقبال لاجئي روسيا كان في البداية استمراراً لتقليد التسامح المتبع في الدولة العثمانية منذ زمن بعيد، وليس كالإقرار “بحق العودة اليهودي” في القرن العشرين، وأن مفاوضات البيع بين الدولة العثمانية واليهود كانت تختلف جذرياً عن بيع فلسطين في زمن النكبة وما بعدها، الأولى مجرد محاولة لشراء عقار للسكنى تحت سيادة الدولة للعيش في جوار سكانها حتى لو نشأت صراعات جيرة كما نشأت بوجود مختلف اللاجئين في الدولة حتى المسلمين منهم، وما تم من بيع بشكل مشروع أو غير مشروع، كان في هذا الإطار، ولم يقلب وضع فلسطين وما كان له أن يقلبه مع استمرار سيادة الدولة الإسلامية التي يبدو أنهم نسوا ما اتهمت به من تعصب وحصرية تمثيل للعنصر الإسلامي، وأشد المخاوف كانت هي زيادة الأعداد اليهودية التي قد تؤدي إلى مشكلة استقلال ذاتي على غرار المطالب القومية الأرمنية أو مشكلة جبل لبنان الذي صار ذريعة للتدخل الأجنبي، أو مشاكل البلقان، أما الكيان اليهودي المستقل فكان خارج كل الحسابات ولم ينشأ فعلياً إلا على جثة الدولة العثمانية كما قال السلطان عبد الحميد بالضبط، ولكن بيع فلسطين في منتصف القرن العشرين وما بعده كان تنازلاً عن ملكية العرب لهذا البلد وتسليمه للسيادة الصهيونية التي استبعدت الفلسطينيين، فالإطار العثماني للحدث يختلف عن إطار دول الاستعمار ثم دول التجزئة العربية، وأهل فلسطين أنفسهم شعروا بفطرتهم بالفروق الجوهرية منذ بداية انقلاب الأوضاع بعد الحرب الكبرى الأولى، فثوراتهم العنيفة بدأت آنذاك، ومطالبهم وعرائضهم للسلطات البريطانية كانت تفرّق بوضوح بين اليهود الذين دخلوا قبل الحرب، أي في الزمن العثماني، والمهاجرين الذين أتوا في ظل الانتداب والوعود والسياسات البريطانية، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان للخروج بنظرية تفسر أكبر عدد من الحقائق لتكون أكثر قبولاً بدلاً من الاتهامات السطحية.
۞لماذا اختفت تهمة التعصب والاستبداد فجأة من صفحة الدولة والسلطان عندما تعلق الأمر بعروض البيع المزعومة لليهود؟
ولا أدري كيف يفوت علينا أن كثيراً من المؤرخين والباحثين ملئوا الدنيا صراخاً وهم يلقون الاتهامات على تعصب الدولة الإسلامية وعدم مسايرتها لتسامح العصر الحديث، والشكوى عبر الأجيال من استبداد وفردية وتسلط السلطان عبد الحميد، الذي لا رأي لسواه في الدولة، فكيف جاءوا اليوم ليقيموا وزناً لكلام عابر لأي شخص غيره في الدولة ككاتب أو موظف؟ وما هي التهمة: التنازل عن سيادة المسلمين وبيع أراضيهم لليهود، فأي تسامح هذا الذي فاتهم؟ ومن المحزن أن يفوت الباحث بديهية وضع الحدث في ظرفه وزمنه حيث كان هرتزل نفسه مجرد صحفي بارز، ولكنه يرى نفسه بلا قيمة[7] رغم محاولاته لتضخيم إنجازاته، استقبله السلطان بهذه الصفة وكونه زعيماً يهودياً وليس بالصفة الصهيونية[8]، وهذا يختلف جذرياً عن وضع قادة الكيان الصهيوني بعد نصف قرن، لا يجوز النظر إلى مقابلة السلطان لهرتزل كالاستسلام لبيغن وشارون، أو الزعم أن السلطان تنازل لهرتزل في موضوع لم يطالب به هرتزل أصلاً، ورفض مقايضته، وهو الاستيطان التسللي، ثم الادعاء بأن مماطلة السلطان منحت اليهود هذا المكسب، مع أن الاستيطان التسللي نفسه فشل في النهاية بسبب مواقف السلطان وعاد أصحابه إلى رؤية هرتزل الباحثة عن رعاية دولة عظمى تنتشلهم من الفشل واتجهوا إلى بريطانيا التي منحتهم وعد بلفور بعد فشلهم مع السلطان، فلا يجوز نحت انتصارات وهمية للأعداء لمجرد الدخول في صراعات حزبية مع الأحياء وتسجيل نقاط لصالح زعامات هي رموز للتفريط.
هؤلاء يخلطون الأوراق ضمن رغبتهم الجامحة في جمع النقاط والتنقيب عن العيوب في الماضي والتي يغفلون عنها في زمننا، ثم يدينون مقابلة هرتزل ولكنهم يبررون الانبطاح لبيريز ورابين واللهاث خلف التطبيع مع نتنياهو والتوقيع على وديعة رابين كأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن أهلها أنفسهم تخلوا عنها مما بدد أحلام باعة الشعارات علينا بعقد الصفقات مع أعدائنا، ولكن رب ضارة نافعة لهم، فإن استمرار عناد العدو وتأخر التوقيع حتى الآن، يديم وهم الرجل الذي لم يوقع، مع أنه في الواقع يتوق للتوقيع ويحلم ليل نهار بالرضا والقبول من العدو، الراغب ظاهراً، الممتنع واقعاً، ثم تعالوا أتقنوا لوحة البطولة الوهمية بصرف الأنظار إلى أعداء وهميين وركّبوا لهم صوراً بالقص من الزمن البعيد واللصق في الزمن الحاضر ليظهر الفوتوشوب على المقاس تماماً: البطل المقاوم هو القائد الحالي الملهم الذي يرفض التوقيع والاستسلام، والخائن هو ذاك الميت الذي فاوض وعرض وتساهل وغض النظر، وكل ذلك قص ولصق حسب الطلب، أما كيف رُكّبت هذه الصورة البعيدة كل البعد عن الواقع؟ فهذه مهنة البحث السياسي الذي يريد أن ينير العقول العربية البسيطة التي داعبت عواطفها كتابات كثير ممن هم، لسوء حظ السياسة، من المتخصصين المتمكنين من التاريخ، وعندما ترفض هذه العقول البسيطة أبحاث التركيب الإعلامي التي لم يجرؤ عليها أحد حتى الآن بانتظار قدوم المهدي الثقافي، فهذا هو الهجوم الشرس الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها بسبب حقيقة بسيطة ولكنها مزعجة للسياسة وهي أن الشجاعة تكون أمام القصور وليس أمام القبور.
۞من الذي باع بلادنا؟ وأين حدثت الثغرات؟
إن الذين باعوا حلب وفلسطين والعراق وبقية بلادنا لبريطانيا وفرنسا هم أجداد الذين يتهمون اليوم السلطان العثماني الذي خرجت قواته مرغمة من حلب وبقية بلادنا بحرب دموية ضروس لحمايتها من الذين سلموها للإنجليز والفرنسيين الذين استحوذوا عليها ثم طردوا حلفاءهم وخدمهم منها فتبددت أحلام الثوار بالملك والوحدة والاستقلال، ولهذا يجب أن نفهم في ضوء هذه الحقيقة المحزنة أن كل ما يمكن أن يوصف بالثغرات في السياسة العثمانية تجاه اليهود، لم يكن في زمنه ثغرات حقيقية لأنها تمت في ظل دولة كبيرة راسخة منذ قرون ولم تتنازل عن سيادتها، وكل ما قدمته أو غضت النظر عنه، أو غفلت عنه، أو حدث بالتسلل دون علمها، كل ذلك كان في إطار التعامل مع لاجئين تتفاوت سياسات كل الدول في العالم والتاريخ تجاههم، فمرة تستقبلهم بترحاب، ومرة ترفض دخولهم، وتارة تضيق عليهم، وأخرى تهملهم، ورابعة تطردهم، وهكذا، فالتعامل مع لاجئين في ظل سيادة عثمانية قائمة وراسخة منذ قرون يختلف بل يتناقض مع التعامل مع غزاة مستوطنين خارج سيادتنا كما يحدث في واقعنا الحالي.
۞هل كان السلطان بصدد بيع الأناضول أيضاً؟ وهل كان استقبال لاجئي غرناطة بيعاً أيضاً؟ وهل باع صلاح الدين فلسطين للصهاينة أيضاً؟
موقف السلطان عبد الحميد من فلسطين والقدس ليس متوقفاً على وثيقة أو عبارة في مذكرات، الموقف مسجل في مرحلة تاريخية طويلة، نتج عنها نتائج واضحة إذا قورنت بما بعدها، يقولون إن السلطان عرض على هرتزل حلب والعراق وأماكن أخرى، فهل ركزوا في هذه الأماكن الأخرى ما هي؟ إنها الأناضول نفسه، السلطان عبد الحميد عرض استقبال اليهود اللاجئين كما كانت الدولة العثمانية تستقبل المظلومين من شتى الدول الأوروبية الإنسانية التي تضطهد المسحوقين فيها، كان الاستقبال في أرجاء الدولة العثمانية كلها، لاسيما الأناضول التركي نفسه، وفي العاصمة نفسها، حيث استقبلت الدولة العثمانية الملايين من لاجئي القوقاز والبلقان في قرنها الأخير، لقد عرض السلطان استقبال اليهود كما استقبلتهم الدولة بعد سقوط غرناطة في أماكن متفرقة وتحت سيادة الدولة العثمانية نفسها، وكما لاموا الدولة عن موقفها من اليهود في القرن ١٩-٢٠، لامها المراهقون على موقفها زمن غرناطة أيضاً[9] متهمينها بالتوطئة للاستيطان الصهيوني حين كان العالم كله في ظروف بعيدة جداً عن صهيونية القرن العشرين، لأن قراءتهم مراهقة ودونكيخوتية تحارب التنين الذي لا وجود له وهو مجرد طاحونة هواء عادية، والمصيبة أن يكون موجه التهمة، كعادة الباحثين المزدوجة، بعض مثقفي التطبيع والاستسلام للغول الصهيوني الحقيقي في نفس الوقت الذي يحاربون فيه أشباح الماضي التي لا وجود لها، فكيف لو علمنا أن التفاهة وصلت حد اتهام السلطان صلاح الدين الأيوبي قبل أكثر من ثمانية قرون بالتهمة الصهيونية ذاتها[10]؟ وهو مظهر طفولي في التعامل مع الأحداث التاريخية عندما تحمّل جريرة تطورات لاحقة لا علاقة لها بها.
۞الفارق الرئيسي والعامل الحاسم هو السيادة
المهم عندنا الآن هو السيادة، فكما أن بعض الدول لديها وافدون وربما تفوق أعدادهم أعداد السكان الأصليين ولا يلومها أحد بل يثنون عليها بكونها حلم الثراء للوافد، مع الشكوى من ممارساتها السيادية التي تضيّق على الوافدين حتى مع كثرة أعدادهم، بل لهذا السبب بالذات، وهذا ما يؤكد أهمية السيادة، نجد هنا في الموضوع العثماني نفس النقطة ولكن مع التلبيس المعاكس، فالأقلية تحت سيادة من؟ هل هي سيادة مستقلة كما كان يريد هرتزل في داخله أم تحت سيادة الدولة العثمانية؟ لماذا عرض عليه السلطان العراق والأناضول نفسه؟ هل كان يعرض دولته في أوكازيون للبيع ومن ضمنه أرض الأتراك؟ شيء من المنطق لو سمحتم، لقد كان العرض عرض لجوء وليس بيعاً، لأنه لن تنشأ لهم سيادة في تلك البقاع، وسيذوبون كما كانوا أقليات في كل مكان، ولوم السلطان عبد الحميد على هذا الأمر لا يجوز لأن الأقليات عاشت وتعيش وتستقبل في كل دول التاريخ البشري وفي جميع البلاد والحضارات، وكان من المفترض على الباحث أن يلفت انتباهه عرض الأناضول لإقامة اليهود وليس حلب وحدها، مع أن اقتراح حلب لم يخطر ببال السلطان ومن قدمه مجرد موظف في كلام عابر، وإذا كان السلطان قد رضي باستيطان يهودي في الأناضول كما قال بالفعل، فهل يعني ذلك أن “الاستعمار التركي” كان يريد بيع أرض الأتراك لليهود؟ وهل كان “المستعمر التركي” بصدد بيع بلده المركزي لليهود؟ فأي استعمار ضحى بدولته المركزية لأجل آخرين؟ هذه تهمة لا تستحق الالتفات، حتى لو قيل إنه عرض على اليهود مناطق يسكنها الأكراد فهذا لا ينفي نظرة الأتراك للأناضول، تقولون لم يكن زمن عبد الحميد قومية؟ نعم صحيح وجميل جداً، وهذا يؤكد ألا فرق بين التركي وغيره وهذا ما نريده، والكردي كان محل ثقة السلطان، والفارس الحميدي كان كردياً، فلا داعي إذن للنغمة التي تشير إلى عروض بيع لليهود كأنها تنازلات عن حقوق قومية للعرب ولشعوب غير تركية، حيث لم يكن وجود لكل هذه التصنيفات العرقية وكانت حلب أهم من الأناضول، الدولة عاملت اليهود في إطار لجوء كثير من الأقليات تحت سيادتها وليس في إطار سيادات مستقلة لها وبيع أراض لجماعات غريبة، فقد استقبلت مهاجري القوقاز في الأناضول وبلاد الشام، ومهاجري كريت في دمشق، ومهاجري الجزائر في بلاد الشام، ومهاجري البوسنة كذلك، وقبلهم مهاجري الأندلس في شمال إفريقيا والأناضول والشام، وبين هؤلاء وأولئك مهاجرين من أوروبا وروسيا باحثين عن الأمان والحرية.
الدولة قاومت بكل قوتها نشوء دول للأقليات، واتخذت من نموذج جبل لبنان درساً قاسياً، والعجيب أن الذين يتهمونها بالتفريط للصهاينة واستقبالهم هم أنفسهم الذين يتهمونها بالوحشية في معاملة الأرمن مع أنها كانت معاملة في إطار منع الاستقلال والسيادة المستقلة، وهو نفس ما كان سيحدث لو حاول الصهاينة الأقل عدداً والأضعف حالاً الحصول على استقلال أيضاً، وهذا ما قاله السلطان عبد الحميد لهرتزل: حصلنا على السيادة بالدم ولن نفرط فيها بأرخص من ذلك، طيب إذا كنتم ضد استقلال أقلية صغيرة كاليهود، مع كونها أقلية تتهمون الدولة بتبنيها، فلماذا تشجعون استقلال أقلية كبيرة كالأرمن وتتهمون الدولة بالوحشية في معاملتهم؟ وتريدون منع استقلال غيرهم؟ فالمهم عندكم هو الإدانة: فالدولة متوحشة حين تمنع الاستقلال عمن تحبون، وهي مفرطة وخائنة عندما تسهل الاستقلال حيث لا ترغبون، فهل بهذه التقلبات تدار الدول، وبأثر رجعي؟
۞ما الذي رفضته السلطنة العثمانية ولماذا؟
الدولة العثمانية كانت تحذر من فخ التدخلات الدولية بذريعة حماية الأقليات وكانت المسألة اليهودية مسألة أمن دولة وليست مجرد قضية أرض وشعب عادي، وكان زوال السيادة العثمانية يعني زوال آخر العقبات في وجه الاستيطان اليهودي كما يقول واحد من أبرز المؤرخين الصهاينة في زمننا هو مايكل أورين، هذا هو رأي العدو في العثمانيين ثم فيمن جاء بعدهم من أعدائهم سماسرة المقدسات، وهذا كل ما في الأمر، ولهذا نقول إن زمن الحدث وظرفه يجب مراعاتهما بدلاً من الإسقاطات اللاحقة، ومن المعيب جعل فضائل الدولة العثمانية في التسامح في زمن، مذمة عليها لأن تسامحها انقلب ضدها بعد زمن طويل، ثم اتهامها في مجالات أخرى بالوحشية والاستبداد لعدم توفر “التسامح” الذي كنتم تذمونه قبل قليل، فهل كانت مفرطة أم مستبدة؟ أم أن كل تهمة حسب الطلب، نتهمها بالتفريط لصالح اليهود ثم نرى الخيانة المعاصرة تستسلم للصهاينة مع صمتنا المطبق بل مع هتافنا وتصفيقنا، فكيف نذم التسامح مع اللاجئ في ظل سيادة الدولة بكونه تفريطاً، وفي نفس الوقت نمدح “التسامح” المستسلم للعدو الغاصب صاحب السيادة المهيمنة على بلادنا؟
إن الصواب أن السلطان لم يكن بصدد أي عملية بيع وتنازل بل بصدد لاجئين كما كانوا يدّعون، ولندع ما كانوا يضمرونه فهو لم يكن مناسباً لذلك الوقت كما أقرّوا بأنفسهم، ولم تسمح لهم الدولة بتحقيقه طوال أيامها، لاسيما أن الذين منحوهم فرصة الإعلان عما كانوا يضمرونه في زمن الدولة العثمانية، هم الذين ثاروا على الدولة وجاءوا لهم بمن يحقق لهم أحلامهم، ولو حاسبنا كل امرئ على ما يضمره، لما تصافح في هذه الدنيا شخصان.
عرض السلطان عليهم خيارات لجوء وحسب، عروضاً تساوت فيها الأرض التركية وغيرها، وشراء الأراضي لإقامتهم يكون في هذا الإطار مثل بيع العقارات للأجانب في أي دولة، وهذا البيع لا ينقل السيادة ولا يؤسسها، السيادة الأجنبية داخل الدول تكون لمقرات البعثات الدبلوماسية ومساكن السفراء فقط، ولا تنتقل بشراء عقارات لمواطنين أو لاجئين أجانب، وإلا لأمكن للعرب ادعاء السيادة على مساحات واسعة من بريطانيا أو تركيا، الحديث عن عروض بيع للصهاينة يقتطع الحدث من زمنه حيث ظروف التفاوض لمجرد استقبال لاجئين في أراض مخصصة، ويلصقه بزمننا حيث المفاوضات والمساومات على تسليم بلاد العرب لكيان صهيوني مستقل ومتغول تحت سيادة أجنبية وحماية دولية طردت واضطهدت وقتلت السكان الأصليين، السلطان رفض إقامتهم في فلسطين حتى يتفادى التدخل الأجنبي الذي يتخذ حماية الأقليات ذريعته وحتى لا ينفذوا خطة السيادة المستقلة ذاتياً كالتي طبقت في أماكن أخرى من الدولة بمؤامرات أجنبية، ولذلك عرض أماكن أخرى منها الأناضول، ووضع العراقيل التصاعدية التي تناسبت طردياً مع تقدم الزمن ووضوح الخطر، أمام تزايدهم في فلسطين، مع أنهم كانوا مجرد أقلية تحت سيادة الدولة العثمانية، لأن خطرهم المتوقع كان تحول فلسطين إلى كيان مستقل ذاتياً ويتدخل فيه الأجانب على غرار جبل لبنان، وهو ما يناقض سياسة السلطان المركزية.
هذا ما كانت الدولة تقاومه في حياتها بكل قوتها كما قاومت الاستقلال الأرمني، ولهذا قال السلطان لهرتزل إنه لن يوافق على المشروع الصهيوني رغم أن هرتزل استبعد فكرة الاستقلال وشدد على الخضوع للسيادة والقوانين العثمانية، ورفض السلطان ذلك بسبب هاجس التدخل الأجنبي، فحديث السلطان كان يركز على هاجس الاستقلال الذاتي، أما موضوع بيع الدولة والتنازل عن السيادة ونشوء دولة يهودية مستقلة فلم يفكر فيه أي مسئول عثماني فضلاً عن التحدث به، ولم يتحدث به أحد بشكل رسمي، وأعلمهم السلطان أن مشروعهم هذا لن ينجح إلا بسقوط الدولة العثمانية، ولا أظن أن أحداً عاقلاً يفهم بعد ذلك من العبارة الدارجة: لن تمروا إلا فوق جثتي، أنه سماح لهم بالمرور وترتيب للتنازل وتسهيل مهمة العدو ولكن بعد الوفاة، أو أنها عملية توريث، أو أن الحي يرتب وفاته ليريح عدوه منه، ولكن هذا هو منطق الدعاية السياسية.
۞الدعاية السياسية رمتني بدائها وانسلت
وبغض النظر عن الإجراءات التي اتخذت ضد استيطان اليهود، وهي كثيرة وتنامت مع مرور الزمن وزيادة وضوح الرؤية والخطر من (الاستقلال الذاتي)، وكان لها كثير من النتائج في العهدين الحميدي والاتحادي، ولكن كما سبق القول كان الصراع بين الطرفين، بل قمع السلطة للمستوطنين، على أرضية من السيادة العثمانية وليس صراعاً بين سيادات مستقلة، ويا ليت أن أنظمة الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي تكيل دعاياتها الاتهامات قامت ببعض ما قام به العثمانيون، بدلاً من الشعارات الفارغة، نسأل من الآخر: هل منحهم السلطان سيادة بإقامتهم في فلسطين كما كان هرتزل يريد، وكما توصل إجماعهم بعد ذلك؟ وكما أجمع على منحهم تلك السيادة حكام بلادنا من التقليديين والثوريين على حد سواء؟ الدكتورة فدوى نصيرات بنفسها رغم نقدها المرير للسلطان عبد الحميد اعترفت أنه حافظ على عروبة فلسطين[11]، وهذا ما قاله السلطان لهرتزل وثبت عليه، وهو ما فشلت فيه كل دول الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية، وعندما تكون السيادة لدولة لا نستطيع أن ننتقد إجراءات حدثت بعد زوال سيادتها والتغيير المتعمد للترتيبات والأنظمة التي كانت فيها، بفعل الذين يلومونها والذين هم أنفسهم رحبوا باليهود كسيادة مستقلة وجاءوا بالإنجليز الذين نفذوا مخطط السيادة الصهيونية المستقلة عملياً، وكانت هذه خطيئة العرب وأنظمتهم وليست خطيئة الدولة العثمانية التي كان زوال سيادتها هو الشرط اللازم لتغيير أنظمتها ولتحقيق السيادة الصهيونية، وهذا ما نفذه العرب وحلفاؤهم الأجانب، العثمانيون دفعوا ثمناً غالياً هو أرواح 25 ألف شهيد من جيشهم المنهك في الحرب الكبرى الأولى لبقاء سيادتهم على فلسطين العربية وفيها أقلية يهودية كي لا تصبح هذه الأقلية هي السائدة وكانت ستظل أقلية مثل كل الأقليات في الدولة لو انتصر العثمانيون واستمرت السيادة العثمانية ولما تغيرت هوية فلسطين العربية، ولهذا قال الدكتور وليد الخالدي إن زوال السيادة العثمانية هو الزلزال الأول الذي حل بفلسطين في القرن العشرين مثل زلازل ١٩٤٨ و١٩٦٧ و١٩٩٠ تماماً، العثمانيون تركوا فلسطين بعدما تحالف العرب والإنجليز ضدهم وكان فيها أقلية من ٥٦ ألف يهودي فقط تحت السيادة العثمانية، هنا تتوقف المسئولية العثمانية وتنتقل إلى الحكام الجدد، والدولة ليست مسئولة عن التغيرات التي تلاعبت بترتيباتها بعد زوال سيادتها، فماذا فعل ثوار العرب الأشاوس بهذا العدد الضئيل الذي كان بإمكانهم الخلاص منه بيسر وسهولة في ظروف الثورة والحرب؟ العرب أزالوا سيادة الدولة العثمانية التي تساهلت مع الصهاينة كما يقولون ولكنهم جاءوا بالسيادة الجديدة لبريطانيا حليفة الصهاينة فتضاعف العدد بدل زواله، وصار له سيادة بدل وضع الأقلية، ولو قرأتم ما يقوله المؤرخون الصهاينة أنفسهم لوفرتم على أنفسكم هذا التيه، العدد اليهودي الضئيل زاد إلى أضعاف الأضعاف بعد زوال السيادة العثمانية بفعل الحكام الذين طردوا العثمانيين وليس بفعل مصباح علاء الدين الذي أعطاه العثمانيون لليهود فلم يعد هناك من يقدر على كبح تمددهم، وما تقوم به الدعاية هنا هو تضليل سياسي وليس توضيحاً لأنها تنسى ما روجته بنفسها عن الدولة العثمانية عندما كانت العلاقات التركية الرسمية مع بعض الدول العربية المعنية جيدة، وينسون ويتناسون مواقف الأنظمة التي يدافعون عنها ويعملون في ظلها من فلسطين وحل الشرعية الدولية فيها القائم على التسليم بالسيادة الصهيونية على ٧٨٪ من أراضيها.
والناقدون هم كالتي رمتني بدائها وانسلت، وهذه هي الازدواجية التي ينبغي أن يرفضها الباحث الذي يريد توجيه العقل العربي البسيط، بالإضافة إلى وجوب تحليه بالموضوعية والحيادية التي تذكر المحاسن والمثالب كما يجب، ولكنه لا يطبق ذلك، وكذلك عليه أن يتناول الماضي وفق قوانينه وظروفه الخاصة وليس وفق حاجات وظروف لاحقة لم تكن موجودة وقت الحدث، وافتقاد كل هذا يجعلنا نرفض هذه البحوث المسيسة التي تستعمل أي وسيلة في سبيل الوصول إلى الهدف السياسي المحدد مسبقاً.
۞شهادة هرتزل قبل وفاته بقليل عن ملخص جهوده
قبل أن يتوفى هرتزل بأشهر قليلة في سنة 1904، التقى بوزير الخارجية الإيطالي ضمن لقاءاته مع كبار مسئولي الدول الأوروبية الكبرى لإقناعهم بالتدخل لدى السلطان عبد الحميد لصالح المطالب الصهيونية، وقدم له العريضة التالية لشرح مطالب الصهاينة:
“صاحب السعادة
ضمن المقابلة التي منحتني شرف حضورها في روما، دعوتني لصياغة مطالب الصهاينة، ولهذا فإنني أسمح لنفسي بتقديم الملاحظات التالية إلى سعادتكم.
إن الحركة الصهيونية، ممثلة بمؤتمراتها السنوية التي يحضرها مندوبون من جميع الدول، هدفها إنشاء وطن معترف به قانونياً للشعب اليهودي.
وبصفتي رئيساً للجنة التنفيذية قمت بالتواصل مع الحكومات المهتمة بهذه المسألة، وقد حاولت أولاً وقبل كل شيء إقامة علاقة مع الحكومة العثمانية، واستقبلني جلالة السلطان في مقابلة خاصة ودعاني في أكثر من مناسبة للعودة إلى القسطنطينية، وقمت بذلك فعلاً، ولكن المفاوضات لم تحرز تقدماً ملحوظاً، ولاعتقادي بأن الظروف الدولية هي سبب هذا التأخير، فقد جاهدت للحصول على موافقة القوى الكبرى المعنية، وفي ألمانيا وجدت الفكرة الصهيونية بداية الدعم، واستقبلني القيصر مع مندوبين صهاينة في مقابلة رسمية في القدس في سنة 1898، وأظهر لنا مودته، ولم يتغير الموقف الكريم للحكومة الألمانية منذ ذلك الوقت، وتأكد ذلك بالرسالة التي وجهها إليّ صاحب السمو الملكي دوق بادن الكبير في هذا الموضوع في 30 سبتمبر 1903.
وأظهرت الحكومة الإنجليزية ميلاً واضحاً للحركة الصهيونية وعرضت علينا رسمياً مساحة كبيرة ضمن الممتلكات البريطانية في شرق إفريقيا لنستعمرها.
وتكرمت الحكومة النمساوية على جهودنا بالاهتمام، كما قال رئيس الوزراء كيوربر في رسالة كتبها إليّ بتاريخ 28 سبتمبر 1903.
ولكن الدعم الأهم جاءنا من روسيا، ففي أغسطس 1903، كتب الوزير فون بلهفي رسالة إليّ تجد نسخة منها في طي المظروف، وأضاف فون بلهفي أن إعلان حكومته نقل إليّ بناء على أوامر جلالة الإمبراطور مع الإذن بنشرها، ففي 23 نوفمبر(حسب التقويم في روسيا)، 6 ديسمبر 1903، أعلمتني الحكومة الروسية أن السفير الروسي في القسطنطينية تلقى تعليمات للتدخل لدى الباب العالي بالنيابة عن المطالب الصهيونية.
لقد كان إعلان الحكومة الروسية في 30 يوليو (حسب التقويم في روسيا)، 12 أغسطس يعطينا أكثر من مطالبنا، فنحن لم نطلب دولة يهودية مستقلة في فلسطين، لمعرفتنا بالصعوبات التي سيواجهها هذا الهدف، وكل ما طلبناه أن يستقر الشعب اليهودي في فلسطين تحت سيادة جلالة السلطان، ولكن بشروط الحماية القانونية (الدولية)، وتكون إدارة مستعمراتنا بأيدينا، واحتراماً لمشاعر كل المؤمنين، فإن الأماكن المقدسة مستثناة وتخرج عن نطاق السلطة إلى الأبد (يقصد التدويل).
إن كل ما نطالب الحكومة العثمانية به هو الترخيص باستيطان لواء عكا، وفي مقابل هذا الترخيص سنتعهد بدفع جزية سنوية للخزينة العثمانية مقدارها 100 ألف جنيه عثماني.
واقتراحنا هذا يتضمن فوائد جمة للحكومة العثمانية، وإذا كان من السهولة بمكان تعداد هذه الفوائد، فإنه من الصعب أن نسرد بحياد الحالة المزرية التي يعاني منها يهودنا الفقراء في روسيا ورومانيا وغاليسيا….إلخ، والهجرة إلى أمريكا ليست حلاً، ففي كل مكان هناك يجدون أنفسهم من جديد عرضة للاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلاوة على ذلك، فحتى في الدول الحرة، بدأ إغلاق موانئها في وجوههم.
إن معاداة السامية تجعل حياتهم صعبة في كل مكان.
أما فيما يتعلق بإيطاليا، فهذه الصراعات والمشاكل ليست سوى أصداء بعيدة عنها، لأن إيطاليا لم تمس مطلقاً بالمسألة اليهودية، ولهذا السبب تحديداً يمكن لحكومتها تقديم خدمة كبيرة للإنسانية بمد يد العون لحل هذه المسألة المليئة بالأحزان.
إن رسالة من جلالة ملك إيطاليا لجلالة السلطان توصي بمقترحاتنا وتنصحه بمودة أن يأخذها في الحسبان، سيكون لها أثر حاسم في إعادة فتح باب المفاوضات معنا.
إن الشعب اليهودي مشتت ولكنه منتصب رغم كل النكبات، سيقدم عرفانه الأبدي بالجميل لإيطاليا وملكها الشهم.
أرجو من سعادتكم أن تتقبلوا خالص التعبير عن التقدير والإخلاص.
الدكتور ث. هرتزل
فينا، 13 فبراير 1903 (كذا في المطبوع والصحيح 4 فبراير 1904 حسب تسلسل المذكرات والتواريخ المذكرة في الرسالة).
إلى سعادة السيناتور ت. تيتوني، وزير الخارجية، روما”[12].
إن التأمل في هذا الخطاب الذي كتبه هرتزل قبل وفاته بثلاثة أشهر فقط، يبين لنا ملخص جهوده بخط يده، وجواب السلطان النهائي الذي زيفته الدعاية السياسية وألصقت بالسلطان رداً عابراً من كاتبه وليس منه، قصد به اللجوء وليس التنازل، فهرتزل خلافاً للتزييف والتحريف الذي مارسته الدعاية السياسية العربية، فشل في مساعيه للحصول على الترخيص الرسمي من السلطان عبد الحميد، وهو الترخيص الذي كان لازماً لنجاح المشروع الصهيوني كما ثبت بالفعل، ورغم أنه يقدم جهوده للوزير الإيطالي بعدسة وردية، ويحاول إبراز نجاحات حتى لو كانت وهمية أو غير مرغوبة، فلا يذكر أن القيصر الألماني توقف عند إظهار المودة ولم يواصل جهوده لإقناع السلطان بالمشروع الصهيوني مراعاة لرأي السلطنة، ولم يتطرق إلى أن مشروع شرق إفريقيا البريطاني مرفوض لأنه مناقض لمطالبه، هو فقط يستعرض أي إشارة إيجابية حصل عليها من القوى الكبرى ليشجع محدثه على المضي في دعم الصهيونية كبقية القوى الكبرى، ومع ذلك يبدو أن محور حديثه هو فشل جهوده في السلطنة، والرغبة فيمن يعيد تقديمه إلى السلطان ليفتح باب التفاوض الذي أغلقه، وبعد فشله مع السلطان، دار على زعماء الدول الكبرى لعله ينجح في حفزهم على التدخل لدى السلطان، وعلق آمالاً كبرى على روسيا[13]، التي سبق أن منحته وعوداً أكبر من مطالبه، وعلى إيطاليا، لأن السلطان يخشاها في نظره، وقد وعده الملك بنقل قضيته إلى أي عثماني يقابله[14]، وصار هرتزل يقدم كل آيات الخضوع لمن يجعل السلطان يقبل بمفاوضته، فأين الذين يريدون الشهادة الكاملة لهرتزل؟ ويظنون أن موقف السلطان كان أولياً ثم تغير؟ وأين الذين يدعون أن هرتزل هو الذي أقفل باب التفاوض؟ ولماذا يقفله وهو معروض عليه بلاد واسعة في السلطنة كما يقولون؟ ولماذا لم يستغل إشارة السلطان المزعومة بالموافقة على أن “يعمل اللي بده إياه” في فلسطين (قدم عزت باشا العابد لهرتزل في حديث عابر نصيحة بتمويل المشاريع في الدولة العثمانية ومصادقتها، ثم اعملوا ما شئتم، وكل ذلك يقصد منه إفادة الدولة العثمانية وتحت سيادتها وليس أي نوع من التنازل عن أي سيادة ولا عن أي رعايا للسلطان، ولم يكن جواباً نهائياً بأي حال من الأحوال، ولكن أكاذيب الدعاية السياسية جعلت الكلام نهائياً وعلى لسان السلطان نفسه الذي استبعد فلسطين في كلامه بوضوح، ولكن كالعادة “يمكن”[15] فهم الكلام أنه بإمكان اليهود الحصول على فلسطين، أكاذيب ملفقة واستنتاجات مضخمة تناقض الواقع المحسوس وآراء أصحاب الشأن أنفسهم، فلا يا سادة، التاريخ لا يقرأ بكلمة يمكن، التاريخ فيه حوادث ثابتة، لاسيما بعدما رأينا هرتزل حائراً إلى نهاية عمره، ولو كانت المكاسب التي زعمتموها حقيقية لكان هو أو أتباعه أولى بإدراكها ولما أتعبوا أنفسهم في استجداء الدول الكبرى الأوروبية، ولو أنه عاش إلى زمن التجزئة العربية لاعترف بأسماء الذين مكنوه من فلسطين فعلاً وجعلوه “يعمل اللي بده إياه” هو، بل عملوا معه هم “اللي بده إياه” هو.
المهم الآن ماذا كانت نتيجة مساعي هرتزل لتوسيط الدول الكبرى لدى السلطان، وماذا كانت أجوبة الكبار النهائية على هرتزل في مواجهة السلطان “المتساهل”؟
يقول مارفين لوينثال محرر مختصر المذكرات في الفصل الأخير تحت عنوان “الخطوات الأخيرة”: “في مسألة التأثير على الدولة العثمانية، أشار تيتوني إلى حكمة ملكه، والذي بدوره يفعل ما يشير به تيتوني، فبدا واضحاً أن إيطاليا، مثل ألمانيا وروسيا، انضمت إلى قائمة القوى الكبرى الرئيسية التي بدأت راغبة ثم انتهت عاجزة، فجدد هرتزل جهوده للتواصل مع وزير خارجية النمسا-المجر….الذي ضم النمسا أيضاً إلى قائمة الدول التي تتمنى الخير وتنتظر من غيرها اتخاذ زمام المبادرة، ولكن اقتراحه (بريطانيا) الذي لم يكن هرتزل في حاجة إليه، فيما يخص هذه القوة العظمى التي يجب التعويل عليها، كان نظرة ثاقبة وسعيدة في المستقبل، ومع ذلك، فقد تكلف الأمر حرباً عالمية وتدمير الإمبراطورية النمساوية المجرية بالتزامن مع اضطرابات عنيفة واسعة، كانت بعيدة جداً عن التوقعات في سنة 1904، قبل أن تقوم بريطانيا العظمى بتقديم عرض صهيوني حقيقي: وطن قومي في فلسطين، هو سلف دولة هرتزل اليهودية”[16].
وهذا الكلام يجيب عن كثير من الملاحظات عن تلك الفترة، منها أنه مع كل ما قيل عن مفاوضات هرتزل في السلطنة وطول مدتها وما قيل أثناء هذه المفاوضات وما حصل عليه هرتزل من هدايا وعروض، وما أوعزه إليه السلطان في خيال المفترين، كله انتهى إلى لا شيء، اضطر بعدها هرتزل للدوران على الدول الكبرى للتوسط لدى السلطان، فسمع كثيراً من الكلام الجميل، ولكن لم يقدم له أحد شيئاً ملموساً، وما كان يريده هو بعض فلسطين لاستقرار اليهود تحت سيادة السلطان وليس بالانفصال عنه، مقابل مزايا ضخمة للدولة العثمانية، وهذا ما وافق عليه القيصر الألماني[17]، ولكنه أحجم عن التدخل مراعاة لرأي السلطان، وما رفضه السلطان هو مجرد الحديث في مصطلح يمقته هو الاستقلال الذاتي، أما الدولة المستقلة فكانت خارج كل البحوث، فمعركة السلطان كانت مختلفة عن معركتنا نحن، فهو كان يحارب الاستقلال الذاتي، وهذا ما جعله عرضة للاتهام بالاستبداد والأوتوقراطية من نفس الذين يتهمونه بالتساهل مع اليهود، ومعركتنا نحن معركة احتلال، وهرتزل نفسه فهم الحدود التي يمكنه الحديث فيها، على الأقل في ذلك الوقت بانتظار فرص مستقبلية، هذه الفرص جاءت بعد وفاته ضمن انقلاب النظام الذي كان قائماً قبل الحرب الكبرى الأولى، لم يكن الأمر ضمن التوقعات في ذلك الوقت، ولهذا فإن قيام باحثين بتصيد بعض المواقف التي حدثت أثناء هذه الرحلة الطويلة من التفاوض، ليس نهجاً علمياً في الاستدلال، نعم قيل كثير من الكلام، فرأي الملك الإيطالي أن “البقشيش” يمكن أن يحل كل مشاكل هرتزل مع السلطنة[18]، ولكن نيولنسكي الصحفي البولندي صديق السلطان كان رأيه أن السلطان يمكنه إسكان اليهود في الأناضول ولكن ليس في فلسطين[19]، وهذا ما اقترحه السلطان بالفعل، وأن المال لا قيمة له عنده، وأنه يمكن إقناعه بمشروع هرتزل بالدخول إليه من باب القضية الأرمنية والقدرة على تهدئة الأرمن، والحصول على توصية من بسمارك مع قرض ضخم[20]، وقدمت كثير من العروض في الأناضول والعراق، والهدايا البروتوكولية، وتقدمت كثير من الاقتراحات، تساءل الصدر الأعظم عن مساحة المكان المطلوب لأن فلسطين كبيرة[21]، وتحدث عزت باشا العابد عن قبرص مبدئياً مقابل فلسطين فيما بعد[22] وعن التمويل والمشروعات (أيضاً مقابل مجرد سكن لاجئين وليس بيعاً للسيادة)، وتحدث نوري بك عن حلب وبيروت، وتعلق هرتزل بآمال ضخمة ووصلت توقعاته السماء[23]، ولولا ذلك لما استمر في التفاوض، ولكن أيها المؤرخ المحترم، ماذا نتج عن كل هذا؟ لماذا وقفت جامداً عند الهدايا والاستدعاءات والنياشين والنقود الذهبية وتصريحات الحاشية والموظفين وطول فترة المفاوضات، ولم تلحظ أن السلطان الذي كان يستدعي هرتزل “على جناح السرعة” لا يستقبله عند وصوله؟ يقدم له كثيراً من التكريم الظاهري ولكنه يخرجه من آخر زياراته “صفر اليدين”[24]؟ يفاوضه لست سنوات مليئة بالتوقعات ثم يضطره في نهايتها لاستنفار القوى الكبرى كلها للتوسط عنده؟ يحصل من معظم القوى الكبرى على وعود خلابة في الكلام ولكنها تنتهي كلها إلى اتكال أحدهم على الآخر في العمل؟ لقد رأينا ماذا قال هرتزل نفسه وماذا قال محرر مذكراته، وكل هذا جدير بملاحظة المؤرخ المدقق وليس الهاوي المتصيد الذي يريد أن يسوس العالم كله بأثر رجعي من مكتبه الجامعي الوثير، فيقرر أن السلطان “ليس بحاجة إلى أن يدخل في مفاوضات طويلة الأمد تمتد لست سنوات”[25] مع هرتزل (!!)، بالفعل لقد فات السلطان الاستعانة بهذه الخبرات الفذة التي ضاعت فلسطين في زمنها بلمح البصر لعله كان قد استطاع بيعها فعلاً وإعفاء زعماء الأبدية العرب من الخيانة، بدلاً من المساومات الفارغة طيلة السنوات الست.
ولكن ماذا استفاد هرتزل من استعراض “علاقته الشخصية الجيدة مع السلطان”[26]، ومن علاقاته الممتدة وصداقاته المتعددة والتأييد الذي تحظى به قضيته داخل الدوائر العثمانية الحاكمة[27]، وهو يدور في الأروقة العالمية باحثاً عمن يقنع السلطان بإعادة التفاوض معه؟ ويقنع نفسه أو يقنع محدثه وزير المستعمرات البريطاني بأن الخلل في طريقة التفاوض العثمانية: “إنني أفاوض السلطان، ولكنك تعرف ما هي المفاوضات العثمانية، إذا أردت أن تشتري سجادة، عليك أولاً أن تشرب ستة فناجين من القهوة، وتدخن مائة سيجارة، وبعد ذلك تناقش القضايا العائلية، ومن وقت لآخر تتحدث بعض الكلمات عن السجادة، وأنا لدي الوقت للتفاوض، ولكن قومي ليس لديهم هذا الوقت، إنهم يجوعون في حزام الاستيطان (منطقة تركز فيها اليهود في غرب روسيا والدول المحيطة)، وعليّ أن أقدم لهم مساعدة فورية”[28]، ومع ذلك يرفع الناقدون سيوفهم ضد هذا “التردد” من السلطان والذي ترك هرتزل يدور حول نفسه، لأنهم يريدون الحزم الحاسم، من السلطان وحده، ولكن دون الجرأة على مجرد استجداء نفس الطلب من زعمائهم الحاليين العظام الذين جعلوا الاستسلام خيارهم الاستراتيجي.
ولو كان هناك دعم دولي خلف قضيته، فعلام هذا الدوران والاستجداء؟ لأن بريطانيا قبل الحرب الكبرى لم تكن بريطانيا كما أصبحت بعد ذلك، فقد رفض اللورد كرومر رمز الاستبداد الاستعماري تقديم سيناء وهي تحت احتلال بلاده، ولأن روسيا التي قدمت الوعود الخلابة، قال له سفيرها في إسطنبول في نهاية المطاف بعد شهر من تلقي تعليمات الخارجية الروسية بتقديم مبادرة لصالح الصهيونية: “حتى الآن لم أفعل شيئاً في هذا الأمر، ولن يكون من السهل فعل أي شيء”[29]، فعلام يدل هذا؟ هل يدل على تخاذل الدولة العثمانية؟ أم على أنها وافقت لهرتزل أن يفعل ما يريده؟ أم على أن تفاوض السلطان كان خيانة لأمته ودينه؟ أم على أن الدول العظمى كانت تسند هرتزل بكل قواها؟ أم على أنه لا يحق لمراقبي ذلك الزمن أن لا يتخوفوا من الصهيونية التي تدور حائرة باحثة عن طرف حبل نجاة؟
ولعل النقطة الجديرة بالملاحظة أكثر من غيرها، هنا هي ملاحظة المحرر عن تهرب الدول الكبرى من تبني المشروع الصهيوني، وهنا نتحدث عن التبني الواضح على غرار التدخلات الرسمية لصالح ما وصفوه بحقوق الأقليات بالاستقلال أو الحكم الذاتي وتقديم الدعم المادي لها في هذا السبيل، وليس عن توسط بعض الدبلوماسيين لقضايا متفرقة، ذلك التبني والدعم الرسمي لقضية الاستقلال اليهودي، حتى لو كان استقلالاً ذاتياً، لم يكن متوفراً في ذلك الوقت، وطغى عليه قضايا أكبر منه مثل قضايا الأرمن والبلقان، ولهذا كانت ملاحظة مصطفى كامل باشا في محلها عندما قارن بين هدوء اليهود وثوران غيرهم، وصفه كان منطبقاً على الواقع آنذاك، ولم ينقلب الحال إلا في غضون الحرب الكبرى الأولى، ولهذا يمكننا القول إن هذا العامل يمكن أن يكون العامل الأول الذي طمأن المخلصين أن المسألة الصهيونية لن تحصل على موطئ قدم لعدم وجود ذلك الدعم من قوى كبرى معادية والتي كانت تكتفي بطيب الأماني للمشروع الصهيوني، وبعضها يظن أنه في صالح الدولة العثمانية وتحت سيادتها وسريان قوانينها، وكيف نطالب أهل ذلك الزمان بتوقع خطر من قبل جهة غير مدعومة لهدف الاستقلال غير المعلن رسمياً بعد؟ هذا كله كان مشهداً مغايراً تغير عندما قامت الحرب وجاء الثوار بالحلفاء فغابت السيادة العثمانية وحل محلها الإنجليز بسياسة جديدة ما لبث الثوار العرب أنفسهم أن تأقلموا معها.
۞الخلاصة
لقد جرى التعامل مع اليهود في ظل الدولة العثمانية ضمن إطار يختلف جذرياً عن الأوضاع التي نشأت بعد زوال هذه الدولة، فقد كانوا في البداية مجرد لاجئين وأقلية ضمن عشرات الأقليات التي عاشت في الدولة، وجموع اللاجئين التي وفدت إليها على مر القرون، وضمن هذا الإطار من السيادة العثمانية وفد اللاجئون اليهود من روسيا وشرق أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فعاشوا مع بقية مواطني الدولة، وقد اختلفت وجهات النظر في قبول هؤلاء اللاجئين، حتى في المستويات العليا من السلطة العثمانية، فمن رحب بهم كان يعتقد أنهم مفيدون للدولة وأهلها بأموالهم وخبراتهم، كأي دولة تقبل اللاجئين اليوم في ظل سيادتها، وكما أفادت الدولة العثمانية نفسها من لاجئي القوقاز الأقل حظاً في نفس الفترة، ومن اعترض عليهم خشي من كونهم ذريعة للتدخل الأجنبي كما حدث مع أقليات أخرى غير مسلمة في عدة أماكن من الدولة، ولكن الجميع من الموافقين والمعترضين على الهجرة كانوا يتحدثون ضمن السيادة العثمانية وما هو المفيد لها ولأهلها، وليس في بيع أراضي الدولة أو التنازل عنها لسيادة أجنبية، أو طرد سكانها، هذا كان خارج الحديث كله، مثل أي دولة في العالم، ولهذا فإنه حتى ما يسمى بالثغرات في السياسة العثمانية تجاه اليهود عن طريق الموافقة الجزئية على بعض المهاجرين أو الفرمانات الصادرة لهم، أو الرشوة أو المقايضة أو التساهل، يجب أن نفهم أنها كلها كانت في إطار سيادة قائمة دون التنازل عنها أو الإضرار بسكانها، لاسيما في دولة طالما اتهمت بالتعصب الإسلامي وحصر تمثيلها بالمسلمين والانتقاص من غير المسلمين، وهو ما يسمح للدولة بوضع حد لهؤلاء اللاجئين في أي تطور يضر بصالحها، كما حدث فعلاً في ظرف الحرب الكبرى الأولى وكما تفعل حتى أصغر الدول اليوم مع الوافدين إليها، ولهذا فمن التحريف والتزوير وضع أي سياسة عثمانية، أو عرض تقدم به أي شخص رسمي أو غير رسمي في دولة لا حكم فيها إلا للسلطان الأوتوقراطي المستبد، حتى ما يسمى بالثغرات، في صالح نشوء الكيان الصهيوني بعد زوال الدولة العثمانية، وإذا كانت تلك المستوطنات هي نواة الدولة اليهودية كما يزعم، فإنه يجب التذكير أن ليس كل نواة تكبر ولا كل بذرة تنمو، ومن منح البذرة الأرض الخصبة هم الذي طردوا السيادة العثمانية وأحلوا بريطانيا محلها، فالثغرات في السياسة العثمانية كانت ثغرات في تحصين الدولة من شبح التدخل الأجنبي إذا تطور الوجود اليهودي إلى أقلية معتبرة تنال الاستقلال الذاتي وتستدعي الحماية الأجنبية، هذا أقصى ما كان محل خوف وحذر في ذلك الوقت، الثغرات لم تكن في صالح تأسيس الدولة اليهودية مادامت السيادة العثمانية قائمة، ومن هنا ندرك مدى التلبيس الذي يجعل أي سياسة عثمانية تسهيلاً للسيطرة الصهيونية فضلاً عن خيانة بتأسيس دولة يهودية، فالخيانة التي حصلت في زمن زعامات التجزئة كانت بعيدة كل البعد عن السيادة العثمانية في زمنها.
إن المعركة التي دخلتها الدولة العثمانية مع الاستيطان اليهودي عموماً والصهيوني خاصة، تختلف عن معركتنا في هذا الزمن، معركة العثمانيين كانت ضد الاستقلال الذاتي والتدخل الأجنبي، ولو حاول الصهاينة اللعب بهذه الأوراق في زمن السلطنة لواجههم ما واجه بقية التدخلات الأجنبية مثل القضية الأرمنية وقضايا البلقان، وهي ويا للمفارقة حصدت تهم الوحشية والدموية على العثمانيين، ولم يحاول المتهمون النظر فيما كان ينتظر الصهاينة لو حاولوا تحقيق حلمهم بالدولة المستقلة، أما معركتنا اليوم فهي ضد احتلال استيطاني نجح في الاستقلال التام في زمن الزعامات العربية، فلم يكن الاحتلال موجوداً ولا محتملاً زمن العثمانيين، ولا نحن اليوم قادرين على حصر الوجود اليهودي ضمن استقلال ذاتي.
لقد كان الزوال الكلي للسيادة العثمانية هو اللازم لتحقيق الحلم الصهيوني كما حصل فعلاً فيما بعد، والعثمانيون لم يتنازلوا عن سيادتهم إلا بنفس الثمن الذي دفعوه للحصول عليها وهو القتال والدم، حتى في أضعف حالاتهم وآخر أيامهم، وقد حارب جيشهم المهلهل بشراسة في الحرب الكبرى الأولى لبقاء السيادة العثمانية على فلسطين، ولو انتصر الجيش العثماني لظلت فلسطين عربية كما كانت طوال التاريخ العثماني حتى آخره، وإن التلبيس الثقافي الذي يمارس خلط المفاهيم وإسقاط زمن على آخر يزوّر الأحداث ويجعل من صفقة عقارية عادية تحدث في كل بلاد العالم يومياً، خيانة عظمى، مع أنها لم تحدث بالحجم المطلوب للصهاينة وكانت مجرد عروض نظرية في الهواء للاجئين وليس لغزاة، ولغايات بعيدة كل البعد عن نية حتى الصفقة العقارية تحت سيادة الدولة، ولكن التنازل المجاني حدث بعد العثمانيين، والباحث اليوم يلبّس على قارئه في ذلك عندما يخفي الظرف التاريخي والفرق بين وجود سيادة وعدمها، وبين من لم يبع حتى بوجود سيادته، ومن تنازل مجاناً لغير سيادته، فاللاجئ سواء الشرعي أو غير الشرعي الذي دخل الدولة العثمانية تحت سيادتها وفي ظل قوانينها وعاش في مستوطنته على هامش فلسطين وأهلها[30]، وفي هذا الهامش لم يكن الجميع في سلة هرتزل، بل كان منهم من يعادون مشروعه ويريدون اللجوء المعيشي وحده[31]، ولا كانت المستوطنات هي سبب ردود الأفعال العربية[32]، ولهذا فليس من الموضوعية صف قائمة من المستوطنات اليهودية في العهد العثماني والإيحاء بكونها جميعاً إنجازاً صهيونياً، وظل الوضع كذلك حتى بكل ما حصل عليه شرعياً ودون شرعية، إلى أن خرج العثمانيون كلهم، أقول إن ذلك اللاجئ الباحث عن معيشة يختلف عن المستوطن الغازي الذي أقر له زمن العرب بأن فلسطين من حق سيادته التي طردت أهل البلد واستفردت بملكيتها، ومازلنا نرجو المعتدي أن يقبل هو بنا، لا كما كان زمن العثمانيين يرجوهم هو أن يقبلوا به بشروطهم هم وبتقديمه كل التنازلات لهم، وإنه ليس من مسئولية العثماني ما فعله الثوار ضده هم وحلفاؤهم الأجانب بعد طرد الدولة العثمانية من المنطقة ثم زوالها كلياً، ولو حافظ من أتى بعد العثماني على الإرث العثماني والوضع الذي كان في ظله، لما نشأت مشكلة فلسطين أصلاً.
وباختصار لقد طلب الصهاينة من السلطان “المتساهل” سكنى فلسطين مع الاستقلال الذاتي دون المساس بأهلها مع تقديم عدة فوائد للدولة وسكانها، فلم يحصلوا على ذلك منه، فلجأ هرتزل إلى جميع الدول الكبرى قبل وفاته بقليل ليتوسطوا له عند السلطان، فلم يوافق أحد منهم، ولم يحصل حتى بقية اليهود على استيطان آمن بالتسلل، بدليل أنهم لجئوا إلى الدول الكبرى أيضاً على خطى هرتزل، ومن غير الموضوعي الزعم بأن السلطان منح هرتزل تسللاً لم يطلبه هرتزل بل عارضه، ولم يقايضه، وأن هذا التسلل هو الذي ربح منه السلطان ومنح به البنية التحتية لإنشاء الكيان الصهيوني، لأن هذا التسلل نفسه كان فاشلاً بشهادة هرتزل وأتباعه، بل وأتباع التسلل نفسه، ومن المزايدة منحه شهادة نجاح لم تصدق إلا في ظل ظروف لاحقة ولم يكن لهذه النواة أن تنمو إلا برعاية الغرب وحلفائه العرب، ولهذا لجأ الصهاينة جميعاً إلى بريطانيا، وذلك قبل أن تظهر بوادر الانقلابات العظمى في النظام الدولي زمن الحرب الكبرى الأولى، وبهذا حصلوا على احتلال فلسطين ودولة مستقلة فيها في زمن الزعامات العربية العظيمة، وإن محاولات نقل المسئولية بشكل يقفز على بديهيات التأريخ إلى شخصيات بعيدة وصلت إلى صلاح الدين وأخلافه، مصيرها الزوال بزوال الأنظمة العابرة التي تريد تثبيت شرعيتها بانتقاص تاريخ أمتنا بدلاً من تقديم إنجازات أكبر من إنجازاته.
المصادر
[1] -Raphael Patai (Ed), The Complete Diaries of Theodor Herzl, The Herzl Press, New York & London, 1960, Vol. IV, pp. 1614-1616 (February 24, 1904). [2] -محمد حرب عبد الحميد، مذكرات السلطان عبد الحميد، دار القلم، دمشق، 1991، ص 143. [3] -مصطفى كامل باشا، المسئلة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، 1909، ج 1 ص 8.-Raphael Patai, Vol. II, p. 527 (March 24, 1897).
-الدكتور حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897-1909، دار النهضة العربية، بيروت، 1999، ص 238-239.
[4] -Raphael Patai, Vol. III, pp. 1110-1120 (May 19, 1901) [5] -نفس المرجع، ج 4 ص 1579 (23 يناير 1904). [6] -Marvin Lowenthal (Ed), The Diaries of Theodor Herzl, The Universal Library, New York, 1956, p. 343. [7] -Marvin Lowenthal, p. 360. [8] -Raphael Patai, Vol. p. 1092 (May 8, 1901). [9] – شاكر النابلسي، عصر التكايا والرعايا: وصف المشهد الثقافي لبلاد الشام في العهد العثماني (1516-1918)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999، ص 178. [10] – نبيل فياض، يوم انحدر الجمل من السقيفة، منشورات الدار الفاطمية، دمشق، 1993، ص 79-80. [11] -الدكتورة فدوى نصيرات، دور السلطان عبد الحميد الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين (1876-1909)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2014، ص 95. [12] -Raphael Patai, Vol. IV, pp. 1609-1613 (February 4, 1904). [13] -Marvin Lowenthal, pp. 386-405, 413-414. [14] -نفس المرجع، ص 427. [15] -الدكتورة فدوى نصيرات، ص 168. [16] -Marvin Lowenthal, pp.434-435. [17] -محمد روحي الخالدي، السيونيزم أي المسألة الصهيونية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والمكتبة الخالدية، 2020، ص 85. [18] -Marvin Lowenthal, p. 424. [19] -Marvin Lowenthal, p. 127. [20] -نفس المرجع، ص 172. [21] -نفس المرجع، ص 149. [22] -نفس المرجع، ص 156. [23] -نفس المرجع، ص 172 و 173 و 413 و 427. [24] -نفس المرجع، ص 372. [25] -الدكتورة فدوى نصيرات، ص 146. [26] – Marvin Lowenthal, p. 380. [27] -نفس المرجع، ص 414. [28] -نفس المرجع، ص 347. [29] -نفس المرجع، ص 414. [30] -هنري لورنس، مسألة فلسطين، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2006، ترجمة: بشير السباعي، ج 1 ص 166. [31] -محمد روحي الخالدي، ص 60 و72. [32] -هنري لورنس، ص 244.