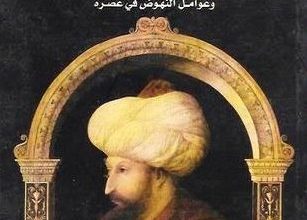تأسيس فكرة خلافة العثمانيين عند المؤرخين: من السلطان عبد الحميد الأول إلى السلطان عبد الحميد الثاني
تعريف بكتاب “خلافة سلاطين بني عثمان بين النفي والإثبات في ضوء المذاهب الفقهية والمصادر التاريخية” للكاتب جاسم حمد الغيث
محمد شعبان صوان
هناك بلبلة واضحة في كلام بعض المؤرخين عن قضية الخلافة عند العثمانيين، فهناك حشد من المؤرخين يزعمون أنها ظهرت في زمن السلطان عبد الحميد الثاني بصفتها رد فعل على العدوان الأوروبي على المسلمين عامة والدولة العثمانية خاصة، وبعض المؤرخين “يتساهلون”، فيلاحظون أن مجرد ذكرها، بدأ في زمن السلطان عبد الحميد الأول وليس السلطان عبد الحميد الثاني، وبينهما قرن، فالقول إذن إنها ظهرت زمن السلطان عبد الحميد الثاني فيه عدم دقة شديد في الوصف، ولكن حتى زعم بقية المؤرخين بعزو الظاهرة إلى تراجع الدولة العثمانية وهزيمتها زمن السلطان عبد الحميد الأول ولهذا لجأت إلى سلاح الخلافة، غير صحيح أيضاً، ولكن يهمنا فيه أن وثيقة واحدة سحبت الظاهرة قرناً كاملاً إلى الوراء فما بالنا لو نظرنا في الكثير من الوثائق الأخرى المتوفرة ولكنها لم تحظ باهتمام بعض أهل الاختصاص؟
بداية إننا لو نظرنا في وثيقة ذلك العصر لتبين أن قضية الخلافة العثمانية كانت من المسلمات آنذاك ولكنها عندما ذكرت في معاهدة دولية للمرة الأولى زمن السلطان عبد الحميد الأول فذلك لأنها المرة الأولى التي يتم اقتطاع جزء من الدولة العثمانية ولهذا صار من الواجب ذكر تبعات هذه الهزيمة على الجزء المفقود وأهله الذين يتبعون الدولة المهزومة تبعية دينية وليست مجرد تبعية فتح، وهو ما جاء ذكره في معاهدة كوتشوك قينارجة (١٧٧٤) بوضوح من حيث مسئولية السلطان العثماني عن شئون أهل القرم الدينية بصفته خليفة المسلمين، هذا هو سر ” المرة الأولى” وليس هو أن العثمانيين اخترعوا فكرة الخلافة للاستقواء بها، أو أن القضية كانت نائمة حتى استيقظت في تلك المعاهدة، ولو اطلعنا على نص المعاهدة التي تضمنت استقلال القرم قبل إلحاقها بروسيا سنجد العبارة التالية: “وطائفة التاتار المرقومة تكون مقبولة ومعترفاً بكونها غير تابعة لأحد سوى الحق سبحانه وتعالى، وحيث أن الطائفة المذكورة هي من أهل الإسلام، وكون ذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة هي إمام المسلمين وخليفة الموحدين، فإنها توجب على الطائفة المرقومة أن لا تلقى خللاً في الحرية الممنوحة لدولتهم وبلادهم، بل يجب أن تنظم أمورها المذهبية من طرفي الهمايوني بمقتضى الشريعة الإسلامية” (تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك المحامي، بيروت، ١٩٩٨، ص ٣٤٤)، فهذا النص واضح في أنه يتحدث عن مسلّمة في زمنه وليس اختراعاً جديداً، أو فكرة استيقظت فجأة، فلا نجد أي جهد مبذول لتأسيس حق من عدم، ولا محاولة للتذكير بفكرة منسية ونفض غبار القرون الطويلة عنها، فالجملة بسيطة ومباشرة: مجرد إشارة إلى إحدى بديهيات ذلك الزمن، ويجب أن نتأكد أنه لو لم تكن فكرة الخلافة موجودة من قبل لما رضيت روسيا المنتصرة بمنح العثمانيين هذا الامتياز على أهل القرم بعدما تمكنت من فرض إرادتها في معاهدة كوتشوك قينارجة ثم صارت شبه الجزيرة في حوزتها وتحت تصرفها المطلق، إذ كيف تسلم للمهزوم بامتياز تم اختراعه بعد الهزيمة دون وجود مستند للمهزوم ولمجرد انتزاع مكاسب من منتصر عنيد؟ ولا ننسى أن معاهدات الهزيمة لم تكن قط هي المكان الأنسب لتأسيس الحقوق الجديدة حيث يتم التخلي عن الحقوق القديمة.
وحتى القراءة المعاكسة لاستقلال القرم واستمرار الولاية الدينية للسلطان العثماني على أهلها، تؤكد الاستنتاج السابق، فهناك من المؤرخين من يرى أن كون السلطان العثماني خليفة للمسلمين أدى به إلى تلقي ضربة قاضية بتنازله عن القرم واستمرار ولايته الدينية على أهلها، وهو ما كان أشد عليه من حماية الإمبراطورة كاثرين للمسيحيين الأرثوذكس في الدولة العثمانية، وفي ذلك يقول المؤرخ بيتر مانسفيلد: “بموجب معاهدة كوتشوك قينارجة سنة ١٧٧٤، لم يفقد السلطان مصطفى الثالث السيطرة على بعض رعاياه المسيحيين وحسب، بل فقد أيضاً سيادته على المسلمين التتار في القرم، وكونه يدعي أنه خليفة الإسلام، جعل ذلك التنازل ضربة تلقاها وأثرت فيه أقوى من تخليه عن حماية رعاياه المسيحيين الأرثوذكس فعلياً للإمبراطورة الروسية كاثرين”.
Peter Mansfield, A History of the Middle East, Penguin Books, New York, 2013, pp. 38-39.
وهذا يعني أن منصب الخلافة كان من مسلمات الوضع الدولي آنذاك مما لم يترك مجالاً للسلطان العثماني لإخلاء مسئوليته من المسلمين الذين صاروا خارج سيادته السياسية كما خلت مسئوليته من غير المسلمين في الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية على مدى ثلاثة أرباع القرن منذ معاهدة بساروفتس (١٦٩٩)، حيث كانت معاهدة كوتشوك قينارجة (١٧٧٤) هي أول حدث يخرج فيه مسلمون كانوا ضمن الدولة العثمانية من سيادة السلطان العثماني السياسية ولم يكن بالإمكان التخلي عن مسئوليته عنهم حتى لو كلف ذلك السلطانين (مصطفى الثالث وعبد الحميد الأول)، اللذين عاصرا هزيمة القرم،حياتيهما نتيجة الصدمة التي سببتها هذه الكارثة غير المسبوقة في تاريخ الدولة ووقعت كالصاعقة عليهما، لا كما حدث في زمن الاستقلال والتجزئة حيث كان الحكام يبيعون البلاد والعباد لأعداء الدين والأمة بجرة قلم من السيد الاستعماري ثم يخرجون منتشين بأكاليل الغار ومزينين بمختلف النياشين اللامعة والأوشحة البراقة تحت أقواس النصر العالية.
وخلاصة الأمر أننا لا يمكن أن نفهم كون فكرة الخلافة قضية مستجدة في معاهدة كوتشوك قينارجة، فإن كانت مكسباً حققه العثمانيون فلم تكن الهزيمة هي وقت تحقيق المكاسب وإن كانت عبئاً أثقل كاهلهم فلم يكونوا وقتها بحاجة لعبء يضاف إلى عبء الهزيمة، إلا أن يكون أمر الخلافة من المسلمات آنذاك بما لم يقدر المنتصر على إنكارها ولم يستطع المهزوم كذلك أن يتملص من واجباتها.
ويمكن توضيح الموضوع بالمثل التالي على تأخر التوثيق الدولي لحقائق مؤسسة سابقاً وهو مثل الوصاية الأردنية على مقدسات القدس، نلاحظ أن الكتابات الأردنية تؤسس حق الأردن بالوصاية، على اتصال نسب العائلة المالكة بالدوحة النبوية الشريفة، ثم ببيعة أهل فلسطين للشريف حسين بالخلافة بعد إلغاء الخلافة العثمانية سنة ١٩٢٤ (لا تذكر هذه الكتابات كونها بيعة بالخلافة، خوفاً من بعبع الاسم على المجتمع الدولي المرهف، بل يذكر كتابها بيعة بالوصاية على القدس) ثم بدفن الشريف حسين في القدس سنة ١٩٣١ ثم بترميم الحكم الأردني كنيسة القيامة بعد حريق ١٩٤٧، ثم بوقوع القدس تحت الوصاية الأردنية بعد النكبة ١٩٤٨ إلى سنة النكسة ١٩٦٧ وهو ما يعترف القانون الدولي بسريانه على المقدسات بصفته مسلّمة، ثم بإعادة إعمار المسجد الأقصى بعد حريق ١٩٦٩.
المهم متى كانت أول وثيقة دولية تذكر هذه الوصاية ؟
في سنة ١٩٨٨ فك الملك حسين الارتباط الأردني بالضفة الغربية ولكنه استثنى الأماكن المقدسة في القدس كي لا يحدث فراغ يستغله الكيان الصهيوني، ثم أشارت معاهدة السلام الأردنية مع الكيان الصهيوني سنة ١٩٩٤ إلى هذه الوصاية، ثم وقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس سنة ٢٠١٣ اتفاقية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة “وتؤكد الاتفاقية بمضامينها على الوصاية الهاشمية التي هي وصاية موصولة” كما يقول الدكتور هايل الدهيسات رئيس قسم التاريخ في جامعة الزرقاء في صحيفة الرأي الأردنية ٢١/٥/٢٠١٣، أي لم تبدأ تلك الوصاية بهذه الاتفاقية.
ماذا يفيد هذا العرض التاريخي؟ يفيد أنه لا يشترط وجود وثائق دولية منذ بداية الحقيقة المؤسسة المعترف بها، الوثائق الدولية تأتي لاحقاً للبناء على ما هو مؤسس وقائم أصلاً ولا تؤسس حقوقاً جديدة لاسيما في حال الهزيمة.
الخلاصة أن الواقع كان يشهد بوجود عملي للوصاية التي تراكم واقعها وتأكد مع الوقت، ولولا هذا الواقع السابق لما أمكن الاحتفاظ بهذه الوصاية للجانب العربي، ثم جاءت وثائق وتصريحات دولية لاحقة، كلها بعد زمن من تأسيس الأمر الواقع وتشريعه، فأقرت وبنت على ما هو موجود أصلاً ولم تكن هي التي اختلقته، لاسيما لطرف مهزوم في المعركة لم يكن في وضع يمكنه من فرض حقوق جديدة لنفسه على المنتصر الذي لم يكن ليقر بهذه الحقوق لو كانت جديدة، مع محاولاته المستميتة للسيطرة على المقدسات وسلب الولاية عليها، لولا أنها مؤسسة على سوابق راسخة، ولو كان الأمر مؤرخاً بالوثائق الدولية وجاء باحث بعد مئات السنين لتأريخ واقع هذه الوصاية من هذه الوثائق وحدها لاستنتج أنها لم تكن موجودة قبل سنة ٢٠١٣، أو ربما سنة ١٩٩٤، وسيكون ذلك استنتاجاً خاطئاً كما كان الاستنتاج بثبوت الخلافة للعثمانيين بالاعتماد على معاهدة دولية استنتاجاً خاطئاً.
فمن يريد معرفة متى بدأ الاعتراف بمنصب الخلافة العثمانية يجب ألا يبحث في الوثائق الدولية بل في مساجد المسلمين وجوامعهم حيث كان الدعاء في الصلوات، وفي كتابات علمائهم وفتاواهم، وفي مراسلات ووثائق الدولة نفسها، وهذا ما فعله الأستاذ جاسم حمد الغيث في كتابه النفيس الذي صدر في الكويت مؤخراً عن دار الرياحين تحت عنوان: “خلافة سلاطين بني عثمان بين النفي والإثبات في ضوء المذاهب الفقهية والمصادر التاريخية”، حيث يبحر في نظرة المسلمين أنفسهم داخل المجتمع الإسلامي، وهذا متفق مع أحد مبادئ التأريخ وهو وجوب النظر إلى الظاهرة كما كانت في زمنها وظرفها وليس وفق ظروف وأزمان سابقة أو لاحقة، فلا يمكننا فرض رؤية قومية رأت أن الدولة العثمانية دولة احتلال في زمن لم يكن فيه قومية أصلاً، وكان الناس يقبلون بحكم أشخاص من أعراق أخرى يشتركون معهم في الدين، وكذلك الخلافة فإنها تخص المسلمين وليس الدول المعادية التي لا شأن لها بالأمر إلا إذا تعلق الأمر بمسلمين تحت حكمها، وهنا يحدث الذكر، وكان ذلك للمرة الأولى في معاهدة قينارجة لأنها المرة الأولى التي خرجت بلاد إسلامية كانت تحت سلطة الدولة العثمانية إلى السلطة الروسية، وإلا فما هو شأن أوروبا أن تذكر في وثائقها الرسمية وجود خلافة في بلاد العثمانيين أو لا تذكر مادام الأمر لا يخصها؟
بل وجدنا أنه في آخر زمان الدولة العثمانية كان الأمر يخص الغربيين بالفعل والبريطانيين منهم على وجه الخصوص، فهم الذين نفخوا في رماد الفتنة بشبهات انطلت على الأغرار الذين ظنوا حرص الإنجليز على نقاوة الإسلام، إذ كانت بريطانيا هي التي تبنت سياسة “الخلافة العربية” لمحاربة الخلافة العثمانية بها، ومن المضحك أنها هي التي بدأت بنشر الادعاء بالحرص على تحقيق الشروط الشرعية للخلافة الإسلامية، وأهمها في نظر الإنجليز آنذاك النسب العربي القرشي، لقد أطلقت بريطانيا هذه الفكرة ووجدت من الأتباع والعملاء من يتبناها في ذلك الظرف العصيب الذي كان المسلمون يمرون فيه وهم في أشد الحاجة لتوحيد الصفوف وليس لتشتيت وشرذمة وتفتيت المجتمع الإسلامي والانتقاص من شأن قيادته التي كانت تحاول جمع المسلمين تحت راية واحدة لمجابهة العدوان الغربي وأطماع الدول الكبرى، ولكن أتباع الغرب من مدعي العلم والفهم ساروا في ركاب المخطط البريطاني لتطبيق الشرع حسب ظنهم، فكانت النتيجة، وهنا العبرة التي يرفض الكثيرون التعلم منها إلى اليوم، أن خسرنا الخلافة العثمانية ولم تقم محلها الخلافة العربية، لأن الذين حاربوا الخلافة العثمانية برمح الخلافة العربية كسروا الرمح العربي بأنفسهم بعد أداء دوره وأفشلوا كل مشاريع إحياء خلافة عربية على أيدي كل الذين طمحوا بها بعد نهاية الخلافة العثمانية، مثل الشريف حسين وملوك مصر، حيث كانت بريطانيا نفسها هي المهيمنة عليهم ولهذا فشلت مشاريعهم، وتبين أن كل دعاوى الغيرة على حقوق السلالة المحمدية والدوحة النبوية، وكل ما جاء في خطابات الغش والخداع البريطاني، مجرد أكاذيب حقيرة استهدفت بنيان الدولة الإسلامية كما حصل بالفعل وأنه مخطئ من ظن يوماً أن للثعلب البريطاني ديناً، ففي الوقت الذي كان فيه السير هنري ماكماهون يسهب ويطنب في خلع الألقاب على الحسيب النسيب الشريف سلالة الدوحة النبوية وصاحب المقام الرفيع، ليعده بخلافة المسلمين بدلاً من سلاطين الدولة العثمانية أعداء بريطانيا، كان لورنس العرب القائد البريطاني في الميدان يؤكد في رسائله السرية أن الغرض من كل هذا الاستدراج هو تحطيم الإسلام من الداخل بالقضاء على سيادة السلطان العثماني بدفع العرب “لانتزاع حقوقهم من الأتراك” وإيجاد خليفة عربي يقاتل الخليفة التركي مما سيقضي على “خطر الإسلام إلى الأبد”، وبالطبع ما أشد التناقض بين الكلام العلني المنمق، والكلام السري المدمر.
ومما يثير العجب أن الحرب نفسها لم تنته بنهاية الدولة العثمانية، وما زال هناك من يشنون عليها حرب الشرعية التي أثارتها بريطانيا وما زالت مستمرة حتى بعد زوال الدولة بقرن، خلافاً لأحكام فقهاء المسلمين، كما بيّن كتاب الأستاذ جاسم، مما يجعلنا نعجب من المفارقة بين الوعي المبكر لجيل الرواد الذي مثله الزعيم المصري الكبير مصطفى كامل باشا رغم حداثة سنه آنذاك، وأمير البيان شكيب أرسلان، والشيخ عبد العزيز جاويش، وثلة من المخلصين، وبين الأدوات المسخّرة في هذه الحرب الذين لم يفيقوا إلى اليوم، رغم كل الكوارث التي حلت بنا من المشاريع الغربية المتتالية، سواء المفروضة علينا أم المعروضة علينا، ولعل مطالعة بعض عبارات المخلصين الذين عاينوا حرب الغرب على المسلمين تفيد في تنوير الأبصار:
يقول الزعيم مصطفى كامل باشا في سبر أغوار العداوة بين الدولة العثمانية وبريطانيا وجذور فكرة الخلافة العربية في نهاية العهد العثماني: “شعرت الروسيا كذلك بعد حرب سنة ١٨٧٧ أنها لا تستفيد من حروبها مع تركيا ما يعوض عليها خسائرها العظيمة في هذه الحروب، ففضلت سياسة مسالمة الدولة على سياسة العداء، فكان هذا التاريخ مبدأ للشقاق والعداوة بين الدولة العلية وإنكلترا، وقد ظهرت هذه العداوة بمظهرها التام الواضح بعد احتلال الإنكليز لمصر، حيث رأى جلالة السلطان في هذا الاحتلال وفي خطة الإنكليز فيه وفي خداعهم لجلالته ما علم منه أن الإنكليز لا صديق لهم وأنهم أكبر أعداء تركيا وأن صداقتهم القديمة المزعومة لم تكن إلا حجاباً ستروا وراءه عداوتهم المرة وأطماعهم الشديدة ضد دولة آل عثمان”.
“ومنذ ذلك الحين عملت إنكلترا على دس الدسائس ضد السلطنة السَنِية في كل أنحاء الأملاك المحروسة…..وقد حسب الإنكليز أنهم يبلغون متمناهم من مصر ووادي النيل ويضعون بذلك أيديهم على الحجر الأساسي للخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية….وقد علمت إنكلترا أن احتلالها لمصر كان ولا يزال ويكون مادام قائماً سبباً للعداوة بينها وبين الدولة العلية وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع إنكلترا على بقائها في مصر، إذ أن مسألة مصر بالنسبة لتركيا والخلافة تعد مسألة حيوية، ولذلك رأت إنكلترا أن بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر، وأن خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هو هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنكليز وبمثابة آلة في أيديهم، ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به استمالة العرب وقيامهم في وجه الدولة العلية، ولكن العرب وغير العرب من المسلمين أرشد من أن يخدعهم الإنكليز بعد ما مر وما جرى من الحوادث (يبدو تفاؤل الباشا مبالغاً فيه في هذه العبارة، فكيف إذا علم أن العرب والمسلمين لم يخرجوا من نفس الفخ بعد قرن الأهوال الذي أعقب وفاته؟)…”.
“والذي يبغّض الإنكليز على الخصوص في جلالة السلطان الحالي (عبد الحميد الثاني) هو ميلة الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية، وهو أمر يحول بينهم وبين أسمى أمانيهم، أي إيجاد الشقاق بين المسلمين وبعضهم وخروج بعض المسلمين على السلطنة العثمانية، ومن ذلك يفهم القارئ سبب اهتمام الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم”.
“وإنكلترا تعلم علم اليقين أنها لو استطاعت أن تجعل خليفة المسلمين تحت وصايتها، أي آلة لها، يكون لها سلطة هائلة ونفوذ لا حد له في سائر أنحاء المعمورة، فإنها تستطيع عندئذ، لا قدر الله، أن تنفذ رغائبها عند المسلمين التابعين لها وغير التابعين، بواسطة هذا الخليفة، ولذلك فهي بعملها على هدم السلطنة العثمانية تعمل على تحقيق غرض بعيد هو أكبر أغراضها وأمنية سياسية دونها كل الأماني”.
“إن مشروع جعل الخلافة الإسلامية تحت وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الكثيرون من سواسهم منذ عهد بعيد، وقد كتب كتّاب الإنكليز في هذا الموضوع، ومنهم مستر بلانت المعروف في مصر، فقد كتب كتاباً قبل احتلال الإنكليز لمصر في هذا المعنى سماه “مستقبل الإسلام” وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني الإنكليز في مستقبل الإسلام، وقد كتب في فاتحة كتابه ما نصه
لا تقنطوا فالدر ينثر عقده ليعود أحسن في النظام وأجملا
أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين، بل إن هذا العقد العثماني يُنثر ليعود عقداً عربياً أحسن وأجمل، ولكن ما لم يقله المستر بلانت هو أن قومه يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانيا لا في جيد الإسلام”.
“ويبين المستر بلانت أيضاً “أن مركز الخلافة الإسلامية يجب أن يكون مكة وأن الخليفة في المستقبل يجب أن يكون رئيساً دينياً لا ملكاً دنيوياً”، أي أن الأمور الدنيوية تُترك لإنكلترا تدبر أمورها كيف تشاء، ويعقب المستر بلانت ذلك بقوله “إن خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجاً لحليف ينصره ويساعده وما ذلك الحليف إلا إنكلترا!”، وبالجملة فحضرة المؤلف لكتاب مستقبل الإسلام يرى، وما هو إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه، أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنكلترا دولة له، ولم يبق للمستر بلانت إلا أن يقول بأن الخليفة يجب أن يكون إنكليزياً!!”، (مصطفى كامل باشا، المسئلة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، ١٩٠٩، ص ٢٣-٢٨).
ويقول في خطبة في القاهرة بمناسبة ذكرى ميلاد السلطان عبد الحميد: “وإني أعرف كذلك أن في مصر جماعة يسعون لحل المملكة العثمانية وإقامة خلافة عربية تكون ألعوبة في أيدي إحدى الدول الأجنبية، فهؤلاء وأمثالهم هم أعداء الدولة والملة وأضر على الإسلام من أعدائه الظاهرين، ولا عجب إذا نبذتهم الأمة المصرية بأسرها واحتقرتهم ظاهراً وباطناً، ولا جرم إذا بشرناهم بالفشل والخذلان وسوء العاقبة، فهذا وقت وجب فيه على المسلمين عامة أن يتحدوا حول راية الخلافة الإسلامية العثمانية ويضحوا أرواحهم في سبيل المدافعة عنها، فهي الرافعة لراية الإسلام وبدونها لا مقام لهذا الدين الكريم ولا حرمة للمسلمين” (مصطفى كامل باشا في ٣٤ ربيعاً، مطبعة اللواء، القاهرة، ١٩١٠، ج ٩ ص ٢٠٠-٢٠١).
اقرا ايضا: هجرة العلماء إلى دولة نور الدين محمود نماذج لامعة في سماء الفكر الإسلامي
وقال في مقال توضيحي في صحيفة اللواء تحت عنوان “سلامة الدولة العثمانية” بعد تلك الخطبة: “إن أعداء الدولة العثمانية يسعون لحل المملكة وتأسيس خلافة عربية تكون ألعوبة في أيدي إحدى الدول الأجنبية… فالدولة العلية حماها الله هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تخشى أوروبا من قوتها ونفوذها، وأعداء الإسلام يودون من صميم أفئدتهم أن يزول اسمها من الوجود حتى تموت قوة الإسلام وتقبر سلطته السياسية، وهم يعملون ليل نهار لبلوغ هذا الغرض السيء، ولما كان وجود الخلافة الإسلامية في قبضة سلاطين آل عثمان، مما يجعل سلطتهم على المسلمين عامة ونفوذهم في أنحاء الأرض قوياً، فقد افتكر أعداء الإسلام في أمر هذه الخلافة العظمى وفي الطرق المؤدية إلى فصلها من السلطنة العثمانية وتسليم زمامها إلى أحد المسلمين الفاقد للعواطف الدينية والإحساسات الإسلامية”.
“ولا يظن القراء أن مسألة الخلافة هي مسألة حديثة بل أن ساسة أوروبا في القرن الثامن عشر اشتغلوا بها كثيراً….”،
“ومن أول يوم استعدت فيه إنكلترا لاحتلال مصر ازداد اهتمام الساسة الإنكليز بمسألة نزع الخلافة من أيدي آل عثمان لأنهم أدركوا أن احتلالهم لمصر يكون إلى الأبد سبباً للعداوة بينهم وبين الدولة العلية وأن جلالة السلطان الأعظم لا يقبل مطلقاً الاتفاق معهم على بقائهم في مصر….فليس علينا بعد هذا إلا أن نقول كلمة واحدة وهي أن سماسرة السوء والفساد في مصر (دعاة الخلافة العربية) يخدمون أغراض الإنكليز ويخدعون الناس بتفهيمهم أن فصل الخلافة من السلطنة يفيد الدولة كما استفادت دول أوروبا من فصل السلطة الدينية من السلطة السياسية، ولكن الدين الإسلامي لا يصح فيه مطلقاً فصل السلطتين من بعضهما لأن الفصل بينهما يقتلهما معاً”.
.(مصطفى كامل باشا في ٣٤ ربيعاً، ص ١١٥-١١٨)
وقال في كتابه المسألة الشرقية إن الإنكليز “عملوا ما في استطاعتهم لتنفير المصريين من الدولة العلية ومن جلالة السلطان الأعظم، فأوعزوا إلى فئة من الدخلاء الذين لا وطن لهم ولا شرف ولا عقيدة بالطعن على جلالة الخليفة الأكبر والسلطان الأعظم، وتشويه أعمال الدولة العلية وأحوالها، ولم يسمحوا بمحاكمة هؤلاء الطاعنين الذين يسبون الأمة المصرية وعقيدتها أعظم السباب بطعنهم على خليفة الإسلام وسلطان مصر” (المسئلة الشرقية، ج ٢ ص ١٢١).
يتبين من هذا العرض المسهب، الظروف التي دفعت بريطانيا لتبني فكرة الخلافة العربية التي ألبستها قناع الدفاع عن أحكام الشريعة، وهي شريعة يبدو أنه لم يعرفها أحد من فقهاء المسلمين في ذلك العصر، فكان على بريطانيا الغيورة على الإسلام أن تعلمهم دينهم لتحيي فيهم الأحكام المهجورة، ولكن من تبعها من المخدوعين والعملاء لم يجنوا سوى الوبال والخذلان، كما قال الزعيم المصري، فسقطت الخلافة العثمانية، ولم تبعث الخلافة العربية، ففقدنا مكانة الدولة العظمى وظلت الأمة مشتتة مشرذمة تلهو بزخارف دولة التجزئة واستقلالها وألقابها وحدودها وسيادتها وكل هذا الزيف بلا أي مكانة بين الدول أو إنجازات لنفسها، وبلا فهم هذا الواقع سيكون بحث القضايا الشرعية مجرد زوابع في فناجين تشغل المسلمين وتلفت انتباههم عما يدبر لهم، ونقاشات سفسطائية تخدم أغراض الأجنبي، ولهذا قال الأمير شكيب أرسلان: “لم يمنعنا من الاشتراك في الثورة العربية سوى اعتقادنا أن هذه البلاد العربية ستصبح نهباً مقسماً بين انجلترة وفرنسا، وتكون فلسطين وطناً قومياً لليهود، وهذا التكهن كان عندنا مجزوماً به، حتى أني كنت أقول قبل الحرب (الكبرى الأولى): لو ارتفع الغطاء ما ازددت يقيناً (وهي عبارة مشهورة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تشير إلى قوة إيمانه بالغيب إيماناً راسخاً يساوي إيمان شاهد العيان الذي لا يزيد عن إيمانه هو قط)، ثم انتهت الحرب، وانتصر الحلفاء، وارتفع الغطاء، فما حصل غير ما كنا نقول” (الدكتور أحمد الشرباصي، شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٨، ص ٨٩)، ويجب أن نتذكر أن هذه الكوارث جلبها أصحابها بنوايا طيبة تريد تطبيق أحكام الشريعة التي ذكرتهم بها بريطانيا صديقة الإسلام وراعية مستقبله، ولمثل ذلك قال الشيخ عبد الحميد بن باديس: “لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله، ما قلتها”، وقد صور السيد محسن الأمين حال المسلمين في هذا المجال بالقول: “مازلنا نتخاصم على شرعية الخليفة حتى صار المندوب السامي خليفتنا”، وليس من المصادفات أن يكون ذلك هو نفسه تعليق الزعيم مصطفى كامل باشا عن الخليفة البريطاني، وهو نفسه ما حدث في الواقع بعد الانقسام الذي أحدثته دعوة الخلافة العربية.
اقرا ايضا: الشيخ “إده بالي”.. المؤسس المعنوي للدولة العثمانية